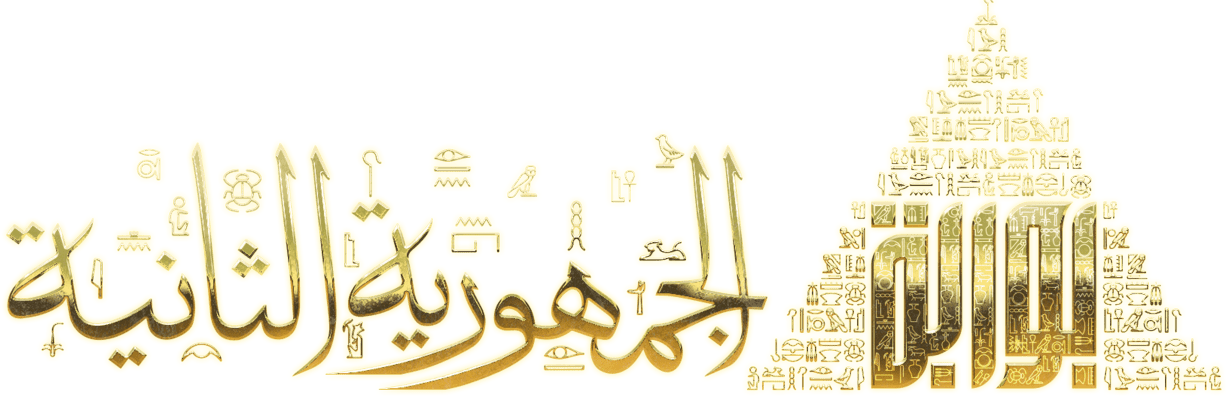أحمد التلاوي يكتب: ماذا تفعل الدولة لاستعادة الثقة مع المواطنين؟!

عندما تأسست الدولة القومية “Nation State” الحديثة بالمعنى الذي نعرفه في عالمنا المعاصر للدولة، فإنها تأسست على مجموعة من الأسس، إلا أن جذرها، ودعامة تأسيسها، هي فكرة “العِقْد الاجتماعي” “Social Contract” بين الحاكم والمحكوم، وفيها تقوم العلاقة بين الطرفَيْن على أساس التزامات متبادلة يحترمها كلا الطرفَيْن.
تناول الكثير من مُفَكِّري عصرَيْ التنوير والنهضة في أوروبا هذه النظرية، ولكن أهمهم، كان هوجو جروتيوس وجون لوك وتوماس هوبز ثم جان جاك روسو، وإن ظلَّ جوهرها هو أن الدولة تقوم على أساس تعاقدي بين الحاكم والمحكوم.
وينهض هذا الأساس التعاقدي الذي يقرر السلطة السياسية وشرعية الدولة، على أساس مبدأ موافقة الشعب على التنازل عن بعض حقوقهم وحرياتهم الطبيعية أو الأصيلة، لصالح الدولة نظير أنْ تقوم الدولة بوظائفها، وبخاصة الحماية وتنفيذ القانون والحفاظ على النظام الاجتماعي، على أساس المواطنة، وليس على أساس العِرق أو الدين أو غير ذلك من صور التباين بين مواطنيها.
تنهض هذه العلاقة على أساس الثقة بين المواطن وبين الدولة، ثم تعزز هذه الثقة الأدوات الرقابية، وأدوات ضبط سلطات الدولة المختلفة، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث تراقب كل سلطة الأخرى، وتعمل على ضبطها متى انحرفت أو أخطأت.
وهنا نقف عند قضية الثقة هذه، والمشكلة القائمة حاليًا بين الدولة والمواطن في مصر.
في الحقيقة، أن المقدمة السابقة، تقدم جانبًا من أهمية ما نحن بصدد مناقشته في هذا الموضِع من الحديث؛ حيث إن الحديث عن أزمة الثقة بين المواطن والدولة في مصر، بات علنيًّا، ولا يمكن إخفاؤه أو التشويش عليه، وصار حديث الناس في المنتديات والجلسات الخاصة.
وجاء اعتذار الحكومة عن الكثير من سياسات المرحلة الماضية، لكي يعمِّق من هذه الأزمة، ولا يعالجها كما تتصور؛ حيث إن المواطنين قالوا إنها سياسات خطأ، من قبل أنْ “تتورط” فيها الحكومة، لكن الدولة أصرَّت عليها.
ثم إنه بعد هذه الاعترافات بالخطأ؛ في غالب الحال سوف تزداد ريبة المواطن ونظرته السلبية لأية سياسات عامة تتبناها الدولة في المستقبل. هذه حالة لا يمكن لأحد أنْ يمنع حدوثها، لأنها – ببساطة – منطقية.
جزء كبير من المشكلة متعلق بتسريع وتيرة إجراءات وقرارات صحيحة كانت بحاجة لوقت أطول لتنفيذها، وبخاصة فيها يتعلق بالدعم، وبخاصة دعم الطاقة والوقود، وبسياسات سعر صرف العملة الوطنية، وهما من أهم عوامل الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطن؛ حيث جذر ارتفاع أسعار السلع والخدمات، في ارتفاع سعر الوقود والطاقة، وفي انخفاض سعر الجنيه.
وبات الوضع لا يجزئ أو يعالج بعض جوانبه سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، وبخاصة مع الفئات الأضعف والشرائح الأقل تمكينًا، مثل أصحاب المعاشات والمرأة المُعِيلة.
العامل الثاني، هو أداء “الموظف العام” أو موظفي العموم في الإدارات الحكومية.
فربما استطاعت الدولة في السنوات الماضية معالجة الكثير من المشكلات ومنها الإهمال والفساد المتراكمَيْن طيلة خمسة عقود، في المستويات المركزية، مثل الوزراء والمحافظين، لكن لا يبدو أن هناك فاعلية كبيرة لإجراءات الدولة في ذلك الاتجاه عند المستويات الوسيطة والأدنى، والتي هي أكثر أهمية لأنها هي التي تتعامل بشكل مباشر، وبصورة أوسع بكثير مع المواطنين.
هذا الأمر، قاد إلى مشكلة حقيقية في نظرة المواطن إلى الدولة، على أنها دولة فساد ودولة جباية، وهما من أخطر وأسوأ الأمور في علاقة الحاكم بالمحكومين، وفيه أساس وجود وليس فحسب أساس استقرار الدولة.
ونعود هنا إلى الأساس الفكري الذي أرسيناه في مقدمة هذا المقال؛ حيث إن بعض مُنَظِّري فكرة الدولة، ومنهم جون لوك وجان جاك روسو، طرحوا سياقات حول كيفية تعامل الشعوب مع مثل هذه الموقف التي تضيع فيها ثقة المواطن بالدولة؛ حيث تكون الدعوة إلى التمرد والثورة على سلطة الدولة، بدءًا بالعصيان المدني، وصولاً إلى الثورة الشاملة إذا ما خرجت الدولة عن أدوارها المرسومة.
وربما كانت هذه الفكرة هي عمود الأساس الذي قدمته مراكز البحوث ووسائل الإعلام الهدَّامة، وبعضها صهيوني، مثل مركز “حاييم – سابان”، التي لعبت دورًا من أخبث الأدوار في تحريك فوضى ما عرف بـ”الربيع العربي” في السنوات الماضية؛ حيث كانت كلمة حق وإنْ أُريد بها باطلاً وشرًّا ببلادنا العربية، ومنها مصر.
والمشكلة الحقيقية في هذا السياق، هي أن الشعب المصري، بطبيعته، من الصعب للغاية استرداد الثقة منه من جانب أي طَرَف كان، متى فقدها هذا الطرف، خاصة وأن المواطنين كانوا يعلِّقون على التغيير الذي حدث في مصر في العامين 2013م و2014م آمالاً طوالاً في تبدُّل جوهر الوضع الذي ساد في العقود الماضية، وقاد إلى ثورة يناير 2011م، التي تم حَرْفُها عن مسارها الصحيح من خلال بعض الأطراف الهدَّامة، مثل جماعة الإخوان الإرهابية، وكان لسفارات دول الضد، مثل السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية دور كبير في ذلك.
فبرغم كل المدينية التي تعرفها مصر، ويعرفها تاريخها الحضاري الطويل؛ فإنه تبقى عقلية الأرياف، عقلية أهل الأقاليم، من مناطق الصعيد والوجه البحري، حاكمة في سلوك الناس في هذا الإطار، ونجده في علاقات بعضهم البعض؛ حيث إنه لا رجعة لديهم في أية علاقة بينهم وبين شخص أو طَرَف خان أو لم يلتزم باتفاق سابق بينه وبينهم، وهذا معروف.
وبالتالي، ووفق هذا المعنى؛ بات الأمر موضعَ خطرٍ كبيرٍ؛ حيث إن فقدان الثقة، يقود إلى تراجع تعاون المواطنين مع الدولة في سياساتها وخياراتها وخططها، بينما هذا التعاون هو أساس تنفيذ الدولة لهذه السياسات والخيارات والخطط.
والتالي؛ فإن الدولة المصرية الحالية، بحاجة إلى تدعيم ثورتها الأولى، التي بدأت في العامَيْن 2013م و2014م، بثورة ثانية، تصحح بها الأوضاع، وتعالج بشكل منهجي وسليم، وحقيقي، المشكلات التي قادت إلى هذه الحالة من فقدان الثقة، والتباعد بين المواطن والدولة.
وأول ما ينبغي على الدولة في هذا الاتجاه، تبنِّي سياسات تقود إلى أثر فوري أو قريب المدى مع المواطن، مثل التعامل مع الفساد في المحليات والدوائر الحكومية الوسيطة والأدنى، وهذا لو حدث، سوف يكون له أثر شبه فوري على المواطن الذي له تعامل يومي مع الدوائر الحكومية.
الأمر الآخر، هو التراجع الجزئي عن سياسات رفع الدعم، مهما كانت المشكلات التي سوف تترتب على ذلك مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي؛ لأن هذه المشكلات لا تُقارَن في خطورتها ولا في أثرها مع المشكلات السابق الإشارة إليها، والتي تمسُّ وجود الدولة نفسها، وتمسُّ استقرارها الداخلي على أقل تقدير، وهو صلب أمنها القومي.
ويتصل بذلك، مسألة صرف النظر نهائيًّا عن فكرة التحوُّل إلى الدعم النقدي؛ لأن الإحساس الذي وصل إلى المواطن عند الإعلان عن هذا الأمر، هو أن الدولة تواصل “بأسلوب خبيث” سياساتها في التخلِّي عنه.
أيضًا من الأمور التي يمكن للمواطن ملاحظتها بشكل فوري أو شبه فوري، مسألة ضبط الأسعار وضبط الأسواق؛ حيث هذه من أهم الأمور التي تثير نقمة المواطن على الحكومة والدولة.
يشمل المطلوب أيضًا وقفة تعبوية – بمصطلحات الجيوش – لسياسات الإصلاح وإعادة الهيكلة، من أجل تقييم أعمق وأكثر دقة لما مضى.
وهنا نقول إن المشكلة الأساسية ليست في طبيعة سياسات الدولة في إصلاح بُنيَة الاقتصاد القومي وعلاج الاختلالات الهيكلية التي لحقت به لدرجة التشوُّه بعد خمسين عامًا من الانفتاح غير المرشَّد.
المشكلة الأصلية في أن هذه السياسات لا تتفق مع الوجدان الجَمْعي عند المواطن المصري، ولا مع المفاهيم السائدة لديه من مفاهيم خطأ، مفاهيم استهلاكية، ولكنها تبقى حقيقة؛ أنها مفاهيم سائدة، يتعامل المواطن بمقتضاها.
ولذلك فإنه وفق كل علوم السياسة والإدارة، بل وعلوم العمران التي لا فكاك من قوانينها، أنْ تعمل الدولة بناءً عليها، تبدأ في إصلاحاتها المطلوبة فعلاً ولكن بناءً على هذه المفاهيم التي كان ينبغي العمل على تبديلها تدريجيًّا، وعلى مدىً طويل لكي يمكن للمواطن استيعابها، أو على الأقل تفهُّمها، وبالتالي، ومع مواجهة الفساد في المستويات الوسيطة والدنيا من الجهاز الحكومي؛ سوف يمكن تمرير مثل هذه القرارات الصعبة.
أمَّا أخذها وتنفيذها بهذه السرعة؛ فقد جعلت المواطن يسيء الظن بالدولة ومؤسساتها، جعلته حائرًا، جعلته يتطلع لوضع – وهذا من أخطر الأمور – لا تكون فيه الدولة أو النظام الحاليَيْن موجودَيْن؛ حيث في مصر الثقافة السائدة هي أن الدولة هي النظام، برغم حطأ هذا المفهوم وقصوره.
أما خطاب الصبر والاعتراف بالخطأ، فلا يُجدي فتيلاً لأن العلاقة بين المواطن وبين الدولة وصلت إلى مرحلة من فقدان الثقة، تجعل فقط المواطن يتعايش مع هذه الأوضاع، الأزمات المتلاحقة في الإقليم والعالم، مع ميل المصريين إلى الطابع السلمي والحفاظ على العمران القائم، وهي سِمَة عند المصريين من آلاف السنين.