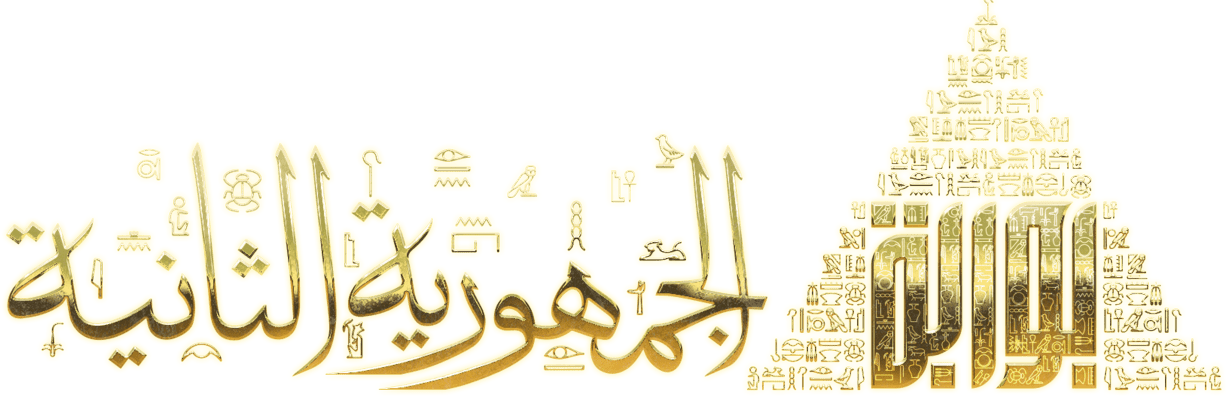متعجلًا أسير.. واضعًا في فمي سيجارة “الصباح”.. أُدخِّنها في نهم.. نداء وصل إلى أذني.. ما إن أستبينه حتى ألقيت السيجارة فزعًا قبل أن أنظر إلى صاحب الصوت.
أستاذ محمد جاد الله.. أستاذي في المرحلة الابتدائية.. واقفًا أمام باب محل بقالة.. اتجهتُ إليه.. فتحَ يديه ليتلقاني في أحضانه.. قبضتُ على يديه اليمنى بكلتا يديَّ، قبَّلتها بلثمات احترام مستمرة.
ما بين سماعي نداءه واستجابتي.. تداعت في ذهني ذكرياتي.. عادت صورته منذ أربعين عامًا.. واقفًا بجسده القوي كمصارع مُنتفخ العضلات والأوداج بوجهه المستدير القمحي المائل للسمار.. واقفًا أمامنا في الفصل.. على يديه بياض “الطباشير”، -وأصابع بيضاء من جِير الطباشير، كان يكتب بها على حائط اتخذ لونًا أخضر أو أسود يُدعى سبورة، وليست كاليوم خشبية- وسيلة الكتابة والشرح التي ندين لها بفضل التعلُّم، فلم يكن ظَهَر وقتها الأقلام الفلوماستر أو السبورات الخشبية اللامعة البيضاء ووسائل الإيضاح الحديثة، وإلى جواره على مكتبه “خيرزانته” الطويلة الرفيعة؛ وهي نبات مرِن على شكل أسطوانة رفيعة، لُبُّها مُتكتِّل من خشب، وظاهرها أملس -يمكن أن تراها في بعض القرى الآن- لها سُلَّمٌ موسيقي خاص بها؛ إذا طوَّح بها في الهواء بقوة فلها صوت له أثر يفوق أسوأ كوابيسنا.. ولها صوت آخر إذا طوَّح بها في الهواء بسرعة أقل، وإذا نزلت على الأيدي فلها صوت مختلف.. وإذا نزلت على الظهر فصوتها مُغايِر.. وإذا أصابت باطن القدَم، فلها صوتٌ لحينٌ مكتوم، وآخر صارخ إلى جاءت على الساق.
رغم قسوة الخيرزانة “الخرزانة” إلا أنها لم تكن العقاب الأقسى من أستاذنا محمد جاد الله -بارك الله في عمره- كان عقابه بيده المجرَّدة –كنا نسميها طرشاء- أشد قسوة من تلك الخيرزانة.. وكنا نطالبه:
– بالخرزانة أحسن يا أستاذ.
لم نكن نعرف كلمة مستر.. ولا ميس.. فقط أستاذ وأبلة.. وما بين أستاذ وأبلة وبين مستر وميس تطور التعليم إلى ما نحن فيه.
نازعتْ ذكرياتي صورتُه الحالية.. تجاوز السبعين -أطال الله عمره- ما زال وجهه محتفظًا ببهائه.. استعان بعصاة لتنظِّم سيرَه، لكنه هو بسطوته وهيبته وأفضاله.
ساءني أنه رآني أُدخِّن.. وأنا أسأل الله ألَّا يكون لاحَظَها.. فقد كنا حريصين أنا وجيلي ألَّا يرانا أساتذتنا إلَّا في أكمل صورة وأفضلها خُلقيًّا قبل شكليًّا.
تحيَّات حارة خرجت من قلبي لرجل صاحب فضل.. تخللها استفسار عن الأحوال والأولاد وقُبلات مستمرة ليديه تربَّينا دائمًا منذ دراستنا في الابتدائية، أنه وأقرانه -رحم الله موتاهم، وبارك في أعمار حيهم- أنهم في مرتبة “كاد أن يكون رسولًا” اشتقاقًا من ذلك البيت “الشوقي”، الذي كان ماثلًا دائمًا أمامنا في كل مرة يدخل إلينا أحد مُدرِّسينا فنقف له مِن أنفسنا:
قِفْ للمعلِّم وفِّه التَّبجيلا.. كاد المُعلِّمُ أن يكونَ رسولًا
أعَلِمتَ أشرفَ أو أجَلًّ مِن الذي .. يَبني ويُنشئُ أنفسًا وعُقولًا
بإخلاص كأنَّ قلبي الذي يتحدثُ قلتُ:
– بارك الله في عمرك.. لولاكم ما كنا شيئًا.. علمتونا.. ما بخلتم علينا بمعلومة.. قوَّمتونا قبل أن تُفهِمونا.. نَدين لكم بالفضل.. ما نحن فيه أَدِين وجيلي لكم بالفضل بعد الله.. كما تعرف أنا صحفي.. ومحمد صابر مدير عام بإحدى الجامعات -وظللتُ أسرد نماذج من جيلي وما هُم فيه- حتى مَن حالت الظروف بينه وبين استكمال تعليمه، لم تحُلِ الظروف من أن يكون رجلًا محترمًا مسئولًا، أدَّيْتم رسالتكم تجاه الآلاف مثلي.. أطالَ الله في أعماركم ..نحن شهداؤكم أمام الله.. أيديكم التي اتَّسخت من بياض الطباشير تشهد لكم.
أجابني بعين شاردة كأن صاحبها يستعيد ذكرياته:
– أنتم أيضًا كنتم جيلًا محترمًا.. وكذلك والديكم.
هل حقًّا كنا جيلًا محترمًا؟!
أثار ذلك السؤال ذِكرى في نفسي.. في بداية تعليمي الدراسي.. كنتُ في مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية.. وكانت مدرسة عين شمس الابتدائية المشتركة وقتها التي اشتهرت باسم مدرسة “حسني مبارك”، وما زالت، الرقيب الشهيد سيد صبحي حاليًّا، كانت قيد الإنشاء، وبعد مرور شهر أخرج ناظر مدرسة 6 أكتوبر وفقًا لأوامر صدرت إليه مجموعة من التلاميذ لتنتقل إلى المدرسة التي انتهى إنشاؤها، فكان يتوجه إلى فصولنا فصلًا فصلًا معه المدرس رائد الفصل يُطالبُه بإخراج الطلبة “البَليدة” التي كنتُ أنا على رأسهم، أتذكرُ قوله الذي أشعرني -رغم صغر سني، كنت في الصف الأول الابتدائي- بالمهانة والصَّغَار.. وأتذكر قول ناظر المدرسة الجديدة لناظر “6 أكتوبر”: “لا يوجد تلميذ بَليد.. بل معلم فاشِل”.
تلك الكلمة التي أعاد تكرارها ناظر مدرستنا الجديدة بعد ذلك بست سنوات، بعد أن نُظمت أول مسابقة في الإدارة التعليمية لأوائل الطلاب، وكان أول لقائنا مع نظرائنا من مدرسة 6 أكتوبر الذين أطحنا بهم بسهولة، وفُزنا فوزًا ساحقًا بالمركز الأول وجائزة الإدارة ليصعد ناظر المدرسة ويحكي ما حدث من ست سنوات، ثم يُوجِّه حديثه لناظر مدرسة 6 أكتوبر:
– ألم أقل لك إنه “لا يوجد تلميذ بليد.. بل معلم فاشل”؟!
نعم، كنا جيلًا محترمًا.. كنا نهابُ مدرِّسينا أكثر مما نخافهم.. كنا نتلقَّى العقوبة بصدر رحب.. فإذا عُوقبنا فإنه لتقصير فينا.. أساتذتنا لا يضعون السيف في موضع الندى، ولا الندى في موضع السيف.. كنا نرى كلَّ واحد منهم.. “كاد أن يكون رسولًا”.
أتذكر أستاذ محمد بكر.. الذي لما كبرنا اكتشفنا أن الممثل العبقري أحمد زكي يُشبهه.. وليس كما يُقال هذه الأيام.. فهو الأصل، وأحمد زكي الصورة.. نتذكر دخوله الفصل علينا ونحن نتجاذب أطراف الحديث.. فإذا رأينا طرف حذائه يَسبقه قبل دخوله كان الكلام يُحتجز في حلقونا ليسود صمتٌ كأن الصمت يَستمِع.. ونفزع واقفين؛ احترامًا لدخوله، ولا نجلس حتى تخرج الكلمة السحرية من فيه:
– جلوس.
أتذكر أحد زملائنا الذي أصرَّ أن يهرب عبر سور المدرسة.. فرآه أستاذ محمد بكر ممتطيًا أعلى السور كالحصان؛ رجل خارجه وأخرى داخله، فناداه مُلوِّحًا بخيرزانته، فقفز إليه، وشاهدنا زميلنا يبول على نفسه فرقًا قبل أن يصل إليه.
هل كان يجرؤ كائن مَن كان أن يذهب إلى المدرسة دون إنهاء واجبه؟ لا أتذكر أن ذلك حدث.
أتذكر أستاذ جميل معلم العلوم جميل الوجه كاسمه.. وأستاذ مجدي بهيبته المرعبة.. وأستاذ عبدالرءوف بخيرزانته التي لا تفارقه كأنه جزء من جسمه، وأستاذ ألبير بشنطته الجلدية التي كنا نسميها صندوق الدنيا.
جميعهم دون استثناء.. كانوا يتشاركون في صفات الهيبة إلى جانب صفة أخرى مهمة.. لم يكن أحد منهم يجلس في أثناء الحصة.. كان جرس انتهاء الحصة يصدح عاليًا وهم وقوف يشرحون.. بعد أن يتأكدوا أن الجميع حصل على وجبته العلمية جيدًا، وإن كان أحد غير ذلك، فكان يطلب منه المدرس أن يتوجه إليه في حجرة المدرسين لشرح ما استُغلِق عليه.
هل كان آباؤنا محترمين؟!.. كانوا حريصين على أن نتعلم لا أن ننجح.. كانوا يعاملون المدرسين معاملة خاصة.. كأنهم أصحاب فضل -وهم كذلك-.. أذكر زميلي توفيق.. كان والده يعمل “عجلاتي”.. يضع عشرات الدراجات أمام مدرسة 6 أكتوبر ليؤجرها للتلاميذ بعد انتهاء المدرسة “اللَّفَّة” مقابل القرشين والشلن.. أتذكر حينما كان أي مدرس يمر ويلقي عليه التحية:
– السلام عليكم يا “أبو توفيق”.. اليوم عاقبت توفيق بضرب شديد.
ليرد عليه “أبو توفيق” التحية، وعلى وجهه علامات الغضب الممتزج بسؤاله أن يتشرف ليشرب شايًا.. ثم يصب جام غضبه على “توفيق”:
– لماذا ضربك أستاذ محمد جاد الله؟.. ماذا فعلتَ؟ أو: ماذا لم تفعل؟!
لتحتجب الكلمات في فم توفيق، وتخرج تأتآت يتبعها صفعات وركلات من أبيه.
كان العرف السائد أو “السِّلْو” وقتها أن المدرس يضرب والأب يُكمل على ابنه.. كان آباؤنا رغم بساطتهم يضعون المدرسين في أعلى سُلَّم الاحترام والتقدير.. كان إذا مرَّ بهم أحد مدرسينا وهم جلوس.. كانوا يقفون له ويسبقونه بالتحية قبل أن يتفوَّه بها.. ومنهم أخذنا احترامهم.. كانوا في مرتبة مقدسة كانت مرتبة “كاد المُعلم أن يكون رسولًا”.
هل كان من الممكن أن يُهينَ أحدٌ مدرسًا.. أو يُغلظ له في القول؟!.. كان ذلك ضربًا من المستحيل الذي لا يمكن تخيُّله.. كان ولي الأمر يقف كتلميذ خائب مكسور الخاطر إذا أخبره المدرس تقاعس التلميذ منا كأنَّ الذنب ذنبه.. كان لسان حال ذلك الزمان “مَنْ عَلَّمني حرفًا صِرتُ له عبدًا”.. كان بيت الشعر الذي نسبه أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل “الراغب الأصفهاني” في كتابه (محاضرات الأدباء) للإمام الشافعي قائمًا ماثلًا أمامهم وأمامنا:
إنَّ المعلِّمَ والطبيبَ كِلاهما … لا ينصحانِ إذا هُما لم يُكرَما
فاصبِرْ لِدائكَ إنْ أهنتَ طَبيبَهُ … واصبِرْ لجهلِكَ إنْ جفوتَ مُعلِّما
كان خلاصة ما يعظُنا به آباؤنا نسائم رحمات الله عليهم بفطرتهم وما جُبِلوا عليه من حكمة تتلخص في بيت “الشافعي” رحمه الله:
اصبِرْ على مُرِّ الجفا من مُعلِّمٍ.. فإنَّ رسوبَ العلمِ في نَفراتِهِ
ومنْ لم يَذُقْ مُرَّ التَّعلُّمِ ساعةً .. تَذَرَّعَ ذُلًّ الجهلِ طولَ حَياتِهِ
مرَّت أُويقاتٌ بعد ذلك.. جلستُ إلى مكتبي أتطلعُ المواقعَ الصحفية، أدخِّنُ سيجارتي.. فإذا بي أطالع خبر اعتداء على مدرسة في الدقهلية من أولياء أمور لرفضها تسهيل الغش لأبنائهم.. استنشقتُ نفَسًا عميقًا من الدخان.. ساعدني على استرجاع ذكرياتي ومُدرِّسي محمد جاد الله.. فإذا بي تلقائيًّا ألقي بسيجارتي على سجادة المكتب وجِلًا مع معاينة ذاكرتي صورة أستاذي محمد جاد الله.