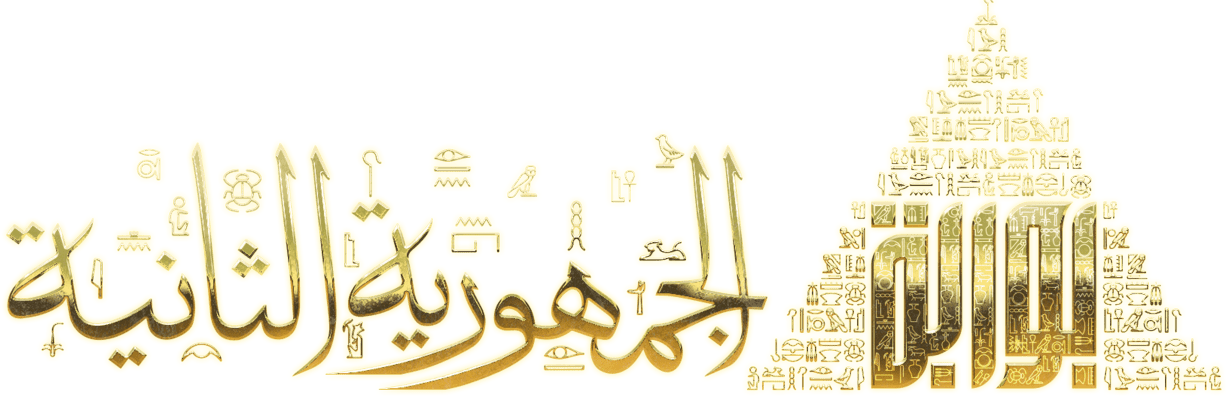هناك أشخاصٌ يكونُ رحيلهم مؤلمٌ، وغيابهم مؤثرٌ فيمن حولهم للحد الأقصي، وهناك مَن لا يغيبون أبدًا، حتى الموتُ نفسه لا يستطيع النيل مِن مكانتهم في القلوب وسيرتهم التي تظل ملهمة لأجيال وأجيال؛ ليذكرهم التاريخ أبدًا ..وأظنُّ أنَّ مِن هؤلاء المشير حسين طنطاوي.
أيُّ فخرٍ يمكن أنْ يَدَّعيه أيُّ شخصٍ أكثر مِن حياةٍ تمَّ تكريسها لحماية البلاد والأرض والعرض، فقد تخرج المشير حسين طنطاوي مِن الكلية الحربية عام 56 ليجد القوى العظمى تشن هجومًا غاشمًا على بلاده، وجد نفسه شابًا يافعًا في آتون حربٍ مستعرة غير متكافئة.
وعندما انتصرت الإرادة المصرية على القوات العسكرية لإنجلترا وفرنسا وإسرائيل، لَم يكد عقدٌ يمضي إلا وطبول الحرب تدق مرة أخرى، ليذوق فقيدنا المشير طنطاوي مع جيله كله مرارة هزيمةٍ مؤلمة على يدِ العدو الصهيوني عام 1967. وإنْ كانت الهزيمة للمدنين تعني المرارة والألم ولكن مع ذلك فالحياة مستمرة بأفراحها وأتراحها، فهي بالنسبة للعسكريين وخاصة مَن هُم مِن طرازٍ فريدٍ مثل طنطاوي يعني أنَّ حياته أصبحت موقوفة على استعادة الأرض والكرامة، وعلى صَعيديٍ مِن النوبة بلاد الذهب، تكون قسوة الهزيمة أضعاف.
ولكن مع هذا الطراز الفريد مِن الشخصيات يتحول الألم لعزيمة، والمرارة لإرادةٍ لا تلين، والإحساس بالهزيمة لنار تستعر لا تنطفئ إلا بتحقيق النصر.
وقد كان له ما أراد، حيث شارك في حرب الاستنزاف إلى أنْ خاضَ حرب أكتوبر قائدًا للفرقة 16 ليعبر القناة مع الأفراد مِن جنودنا الأبطال ليعود لنا بأرضٍ محررة وكرامة مستردة وراية خفاقة.
ومع هذا يبدو أنَّ تلك الحياةَ الحافلةَ بالحروب لَم تكن إلا تهيئةً لمهام أخرى مِن العيار الثقيل، ولكنها في هذه المرة حرب عقولٍ وإرادات، لا تقل خطورة عن أي حرب خاضها مِن قبل، فهي حربُ وجود للدولة المصرية نفسها.
فقد تحمل مسئولية مصر فى واحدة مِن أصعب وأدق لحظاتها التاريخية التي مرت بها واستطاع هو ومَن معه إدارة الأزمة بجدارة وحكمة وصلت بها لبر الأمان.
وكانت آخر حروب المشير طنطاوي مع الأسف مع المرض الذي لَم يملك إلا الاستسلام له في النهاية، ولكنه مضي في سلامٍ إلى حيث لا صخَب ولا نصَب ولا حروب ولا صراعات.. فلروحه السلام وهو وجميع الغائبين الحضور.