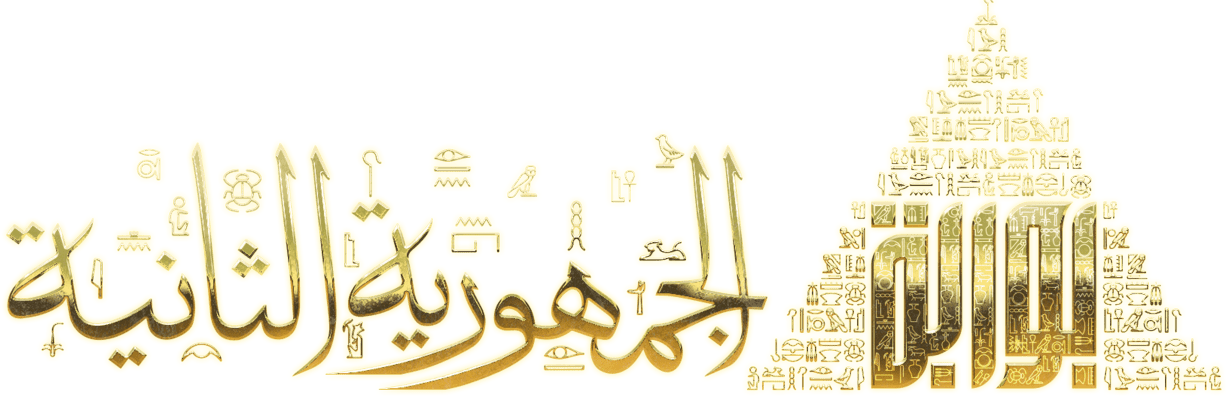إعداد: أحمد التلاوي
التصعيد على عَتَبَات الخطر.. ربما كان هذا هو العنوان الأكثر تعبيرًا عن المرحلة الحالية التي تمر بها الحرب في منطقة أوراسيا، بين روسيا وأوكرانيا، ومن وراء كليهما تحالف أو معسكر يسعى كل منها إلى إثبات قدرته على قيادة النظام العالمي.
كان استخدام أوكرانيا لصواريخ “أتاكامز” الأمريكية و”ستورم شادو” في ضرب العمق الروسي، والرد الروسي باستخدام صاروخ “أوريشنيك”، بمثابة دخول الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة.
وفي الحقيقة، فإن الأخبار المتعلقة بسماح الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى تدعم أوكرانيا باستخدام الأسلحة المتقدمة التي تزود بها كييف في ضرب العمق الروسي، هي اخبار مُلتَبَسَة؛ حيث يتم تداول التأكيد والنفي في ذلك الوقت، لكن الأكيد أن أوكرانيا استخدمت الصواريخ الأمريكية والبريطانية المتطورة في ضرب روسيا، مما حدا بالروس إلى استخدام الصاروخ الأحدث
ولكن، من المهم هنا التأكيد على نقطة مهمة لتوضيح الصورة، وهي أن الـ”أتاكامز” والـ”ستورم شادو”، لم تكُن بداية التدخل الغربي المباشر في الحرب الأوكرانية بما يستهدف الأراضي الروسية.
فأوكرانيا منذ بداية الحرب، تستهدف قلب الأرض الروسية، بما في ذلك أهداف في العاصمة الروسية موسكو، وفي سان بطرسبرج، المدينة الثانية الأهم في روسيا، بالطائرات المُسَيَّرة، وبالطبع المناطق الحدودية القريبة، مثل بيلجورود، بالمدفعية والصواريخ.
كورسك والتدخل البريطاني المباشر
الأكثر أهمية مما مضى، أن أوكرانيا، وضمن ما أعلنته باسم “الهجوم المضاد” في ربيع العام 2023م، لم تحقق الكثير فيه، بدأت في عملية عسكرية في أغسطس الماضي، في منطقة “كورسك” الروسية، واستولت بالفعل على مساحات ربما تصل إلى مساحة بلد مثل لبنان أو أقل قليلاً.
وهنا نتوقف قليلاً أمام عملية كورسك – السلطات الروسية أعلنت قبل أيام أنها استردت أكثر من ستين بالمائة من الأراضي التي كانت أوكرانيا قد استولت عليها – حيث فيها بعض الأمور الواجب ملاحظتها بشأن مسألة دخول بريطانيا على وجه الخصوص في الحرب الروسية الأوكرانية.
أولاً نقول، إنه منذ بداية الحرب، من المعروف أن بريطانيا على وجه الخصوص لها عناصر من الاستخبارات العسكرية منتشرة على الأرض في أوكرانيا وجبهتَيْ دونيتسك ولوجانسك؛ حيث تدور المعارك الأساسية للحرب، بجانب منطقتَيْ أوديسا وخاركيف، وتدعم سلطات كييف بالمعلومات الدقيقة.
إلَّا إن واستطاع الروس قتل عدد منهم، بما اضطر بريطانيا إلى سحب معظمهم، والاعتماد على الاستخبارات الرقمية، بواسطة الأقمار الصناعية، بأكثر من الاستخبارات البشرية.
لكن الأهم منذ ذلك أن عملية كورسك التي تمت، من الواضح تمامًا وجود تخطيط خارجي فيها؛ حيث تمت بذات النسق الذي تمت عليه عملية تحرير كورسك وأوكرانيا بعدها من النازيين في الحرب العالمية الثانية.
والذين يتمتعون ببعض المعرفة في مجال التأريخ العسكري، يجدون أن بريطانيا والولايات المتحدة، كثيرًا ما استعملوا هذا الأسلوب، وهو ما تم حتى مع مصر خلال حرب يونيو من العام 1967م؛ حيث أمدَّهم الأمريكيون بوثائق بريطانية مهمة للغاية عن العدوان الثلاثي في العام 1956م، مما أفاد الإسرائيليين كثيرًا.
وفي أفغانستان، سواء خلال سنوات الاحتلال السوفييتي في الثمانينيات، أو بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، وفي العراق خلال حرب العام 2003م، كانت الأدوات البريطانية حاضرة، وأكثر فاعلية بكثير من الأمريكيين.
لذلك، فإنه لا يمكن القول إن “تطورًا ما” بعينه في الفترة الأخيرة دفع روسيا إلى تصعيد نوع السلاح الذي تملكه، باستخدام صاروخ “أوريشنيك” في الحادي والعشرين من نوفمبر الحالي في مدينة دنيبرو الأوكرانية.
كما أن روسيا ليست المرَّة الأولى التي تستخدم فيها أسلحة نوعية في أوكرانيا؛ حيث استخدمت من قبل صواريخ فرط صوتية وأسلحة نوعية أخرى في الحرب الأوكرانية.
إذًا، فلماذا كل هذا القلق الغربي، والحديث في أوروبا عن حرب عالمية ثالثة محتملة أو حرب نووية قادمة؟.. يتعلق ذلك بطبيعة الصاروخ الجديد الذي يمثل في طبيعته تهديدًا كبيرًا للأمن الأوروبي.
“أوريشنيك”.. كابوس أوروبا الجديد
لا توجد أرقام صحيحة مؤكدة حول سرعة ومدى الصاروخ، فبينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان في حجنه، إن صاروخ “أوريشنيك” من الصواريخ متوسطة المدى. والتي يتراوح مداها بين ألف إلى خمسة آلاف وخمسمائة كيلومتر، فإنه بحسب تقارير غربية، فإن الصاروخ أُطلق من قاعدة “كابوستين يار” بمقاطعة أستراخان أوبلاست الروسية، وبالتالي؛ فإنه قطع مسافة تتراوح بين 800 إلى 850 كيلومترًا فحسب.
ولكن هذا لا يقلل من شأن الصاروخ بالمناسبة؛ حيث إن مشكلته الأساسية أصلاً لدى أوروبا، هو أنه يُطلق من مسافات أقصر كما سوف نفهم.
أيضًا بوتين أشار في بيانه إلى أن الصاروخ زُوِّد بـ”حمولة غير نووية فرط صوتية”، وأن الرؤوس الحربية للصاروخ “هاجمت أهدافا بسرعة 10 ماخ” أي ما يعادل ما بين 2.5 إلى 3 كيلومتر في الثانية.
ولكن منظمة غير حكومية تُسمَّى بـ”مركز السيطرة على الأسلحة ومنع انتشارها”، وهي في الأصل منظمة تابعة للاستخبارات البريطانية، قالت إن الصاروخ يمكنه التحليق بسرعة أقل، حوالي 3200 كيلومتر في الساعة، أي حوالي 900 متر في الثانية.
وتم تطوير الصاروخ في “معهد موسكو للتكنولوجيا الحرارية”، وهو أحد موقعَيْن يتم فيهما تصنيع هذه النوعية من الصواريخ الباليستية في روسيا، بجانب “مركز ماكييف لتصميم الصواريخ”، والأول متخصص في الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والثاني متخصص في الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل.
وفي الغالب، تم تطوير الصاروخ في العام 2019م، بحسب تقارير الاستخبارات البريطانية، وقبل ذلك بعام أصلاً، كان بوتين قد لأول مرة عن تطوير روسيا لصواريخ فرط صوتية باسم “أفانجارد”، وفي حينه أعلنت موسكو أن روسيا تعمل على تطويرها هذه النوعية من الصواريخ لكي تستطيع اختراق الدفاعات الجوية والصاروخية الأمريكية مستقبلاً.
وهنا نقول المشكلة الأساسية في الصاروخ، ليست في قدراته النووية في حد ذاتها، ولكن في مواصفاته الأخرى، والتي ينتهك بها “معاهدة القوى النووية متوسطة المدى” التي أُبرِمَت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، في العام 1988م، من أجل تقليص التهديدات الموجهة إلى أوروبا.
فبشكل مبدأي – إذًا – الصاروخ الروسي الجديد ينتهِك هذه الاتفاقية المهمة للغاية بالنسبة للأمن القومي الأوروبي.
فمن دون الدخول في تفاصيل فنية كثيرة، فإن خطورة الصواريخ الفرط صوتية، وخصوصًا مثل الصاروخ الروسي الجديد في أنه صاروخ فرط صوتي، وفي حالة بلوغ سرعة الصاروخ خمسة أضعاف سرعة الصوت، فإنه تتكوَّن حوله سحابة من “البلازما” – الحالة الرابعة للمادة، وتكون فيها في درجة حرارة مرتفعة للغاية، ذات طبيعة أيونية – حول الصاروخ، فيكون من المستحيل تقريبًا معها رصده.
هنا تظهر خطورة كونه قصير المدى؛ حيث إنه مع عدم قابلية رصده، ودقة توجيهه بطبيعة الحال، كونه صاروخًا باليستيًّا، أو موجَّهًا، مع تعدد عدد الرؤوس الحربية القادر على حملها؛ فإنه يعني أيضًا عدم القدرة على اعتراضه على بُعدٍ آمن من أهدافه، فيكون في حال حمله لرؤوس نووية، بمثابة ضربة انتهائية؛ حيث لا يكون لدى الطَّرَف الذي تم استهدافه أية فرصة لتوجيه ضربة انتقامية مضادة أو ما يُعرَف بالرد النووي.
وهو ما يخل بنظرية الردع النووي التي حالت دون استخدام أي طرف للأسلحة النووية خلال الحرب الباردة؛ حيث إن الردع النووي في حال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقاذفات الإستراتيجية النووية، يتحقق من خلال أنظمة الإنذار التي تمنح الوقت الكافي لاعتراض الصاروخ أو القاذفة، لكن الصواريخ من نوعية “أوريشنيك” ليست كذلك؛ فهي تصل إلى هدفها في وقت لا يتعدى بضع دقائق، كما أنها تُطلَق من منصات إطلاق أصغر حجمًا، بما يجعل استهدافها صعبًا للغاية.
وبالتالي؛ فإن الإعلان عن هذا الصاروخ الجديد يمثل تهديدًا حقيقيًّا، وجديدًا لأوروبا على وجه التحديد.
أسباب حساسية الحرب في أوكرانيا
كل ما سبق مع تفاصيل أخرى كثيرة في الصراع الذي تصاعدت فيه تهديدات باستخدام الأسلحة النووية مرات عديدة من جانب الروس بوجه خاص، يرتبط بحقيقة تاريخية ربما لا يعرفها الكثيرون، في ظل وجود الولايات المتحدة كقوة مؤثرة على القرار العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن لابد من تقديمها لأنها تكمِل أركان الصورة التي تجعلنا نفهم لماذا تضع روسيا في الميدان أحدث تقنياتها العسكرية، بشكل يتجاوز اعتبارات الأمن الحربي؛ حيث يرتبط الموقف بالأمن القومي الروسي، وبالتحديد بوحدة الدولة الروسية بالمعنى الحرفي للكلمة.
يرتبط الأمر بأهمية المنطقة التي تدور فيها رحى الحرب الروسية الأوكرانية الحالية، والمعروفة جيوسياسيًّا باسم “أوراسيا”.
“أوراسيا” جغرافيًّا، هي مساحة اليابسة التي تضم قارَّتَي آسيا وأوروبا، أو “الجزيرة العالمية” بحسب المصطلح الذي استخدمه عالم الجغرافيا السياسية البريطاني السير هالفورد ماكيندر في ورقة عمل بعنوان “المحور الجغرافي للتاريخ”، نشرها في العام 1904م.
أما “أوراسيا” جيوسياسيًّا فهي المنطقة التي تضم روسيا والمجال الحيوي لها في شرق أوروبا وحتى البلقان جنوبًا، وهي المنطقة التي وصفها ماكيندر في ورقته المهمة هذه بـ”قلب العالم”.
وحدد ماكيندر في هذه الورقة أنه مَن يسيطر على شرق أوروبا فقد سيطرة على “قلب العالم”، ومن يسيطر على “قلب العالم”، فقد سيطر على “الجزيرة العالمية” – أوروبا وآسيا – وبالتالي، فقد سيطر على العالم.
وكان هذا الأمر واضحًا في دهاليز أجهزة الأمن القومي والتخطيط الإستراتيجي في بلدان التحالف الأنجلو أمريكي – بريطانيا والولايات المتحدة – التي كانت تقود التحالف الغربي، وتدير الحرب الباردة ضد الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفييتي السابق؛ حيث كان هذا الكيان العملاق يسيطر بالفعل ضمن حدوده، وضمن حدود الستار الحديدي في مناطق نفوذه في شرق أوروبا على هذه المنطقة.
ونقرأ ذلك في كتاب “رقعة الشطرنج الكبرى”، لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق زبجنيو بريجينسكي، والذي صدر في العام 1997م، والذي تناول فيه مصطلحات ماكيندر عن “قلب العالم”، والذي اعتبره “مركز القوة العالمية الجديد”.
كانت هذه القراءة من بريجينسكي استجابة لحركة قومية ظهرت في روسيا باسم حركة “البِيض” بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، ونادت فيها بأن هوية روسيا ليست أوروبية ولا آسيوية، وإنما لها هوية مستقلة تدور حول المناطق التي نشأ فيها السلاف، والذين جاء منهم الروس الحاليون، عند حوض نهر الفولجا قبل قرون بعيدة.
وهو ما يفسر سبب سعي روسيا لتأسيس تكتلات تضم هذه الدول لتمتين الجبهة الأوراسية لو صحَّ التعبير، في مقابل مساعي الغرب لضم دول أخرى إلى تحالفاته، مثل الاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو”، من أجل تحقيق أكبر قدر من التفكيك الممكن للكتلة الأوراسية، مع ما تمثله المشروعات الروسية من إعادة إحياء للاتحاد السوفييتي السابق، ولكن على أسس أكثر متانة وتماسكًا، وبالطبع الغرب لن يسمح بذلك بسهولة.
وتفكيك الكتلة الأوراسية في الخطط الغربية، يتضمن تفكيك روسيا نفسها إلى جمهوريات أصغر حجمًا ضمن مخطط بريطاني قديم تم إرساؤه في زمن الاستعمار المباشر، ولا يزال حاكمًا للسياسات الغربية في العالم، وهو تفكيك المركزيات الكبرى، وإضعافها للحفاظ على التفوق الغربي في العالم.
فنرى – على سبيل المثال – خرائط للصين تتضمن علامات حمراء وصفراء، تتعلق بما يطلَق عليه “خطوط الصَّدع” الجيوسياسي لهذه الدولة الكبرى، والتي تهدد بقطاعها الصناعي النظام الرأسمالي العالمي الغربي بكفاءة.
كما يمكن وضع الحروب الانفصالية التي اندلعت في روسيا، في الشيشان وداغستان، في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة في نفس الإطار؛ حيث حاول الغرب تحقيق أهدافه التفكيكية في الكتلة الأوراسية واستكمال مخططه لتفكيك روسيا بعد الاتحاد السوفييتي السابق استغلالاً لحالة الضعف التي كانت عليها الدولة الروسية آنذاك.
جانب من أهمية هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 22 مليون كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 400 مليون نسمة، يكمن في ثرواتها الطبيعية؛ حيث تحتوي على أكبر احتياطيات عالمية من الغاز والنفط وثروات تعدينية أخرى، كما أنها تحتوي على أكبر احتياطي للمياه العذبة في العالم، وهذه شكَّلت مع ضمِّ روسيا لأقسام واسعة من مساحتها الحالية، في الجنوب الغربي، عنصر قوة كبير لروسيا؛ حيث هي أكبر مورد للقمح والحبوب في العالم.
من هذا يمكن فهم موقف روسيا من انضمام دول البلطيق الثلاث لحلف “الناتو”، وتحركات روسيا عسكريًّا في جورجيا وأوكرانيا؛ حيث ضمَّت بالفعل الكثير من المناطق التي بها أغلبية روسية مثل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا، وشبه جزيرة القِرم الإستراتيجية وجزء كبير من جمهوريَّتَيْ دونيتسيك ولوجانيسك في أوكرانيا.
هل يمكن اندلاع صراع نووي؟
الحقيقة أن قرار مثل هذا يتخذه أي طرف من أطراف الأزمة، ليس بالسهولة التي يتصورها عوام الناس، وليس بالسهولة التي تأتي على لسان بعض القادة الأوروبيين أو بوتين نفسه؛ حيث إن إطلاق سلاح نووي، ليس قرارًا فرديًّا، ولا يؤخذ بناء على تقدير موقف ما لأية جهة عسكرية أو استخبارية، وإنما هناك وثائق ومدوَّنات تحدد بدقة حالات استخدام السلاح النووي في البلدان التي تمتلكه.
وذلك نراه عندما تقوم دولة ما بتحديث إستراتيجيات أمنها القومي والعقيدة العسكرية التقليدية والنووية لها، كما فعلت روسيا في السنوات الماضية مع بدء حلف “الناتو” في ضم بلدان من الجوار الحيوي الروسي، في شرق أوروبا، وكان آخرها إعلان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في التاسع عشر من نوفمبر الجاري، أن التعديلات التي أدخلتها روسيا على عقيدتها النووية تمت صياغتها عمليًّا بالفعل و”سوف يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها عند الضرورة”.
وهو ما يعني أن القرار النووي لا يكون عفو الخاطر، أو استجابة آنية فورية، أو حتى انفعالية، لحَدَث ما مفاجئ غير نووي الطابع، حتى ولو كان غزوًا عسكريًّا لأراضي الدولة.
الحالة الوحيدة المُؤكَّد فيها استخدام دولة ما لسلاحها النووي، هو أنْ يتم “بالفعل” استخدام بلد آخر لسلاحه النووي ضدها، أو بدأ “فعلاً” في استخدامه، مثل إطلاق صاروخ أو قاذفة إستراتيجية بهدف قصف أهداف في بلد ما بالسلاح النووي.
وليس حتى هناك ما يُعرَف بـ”ضربة نووية إجهاضية”؛ إذ يمكن للدولة التي تم قصفها بالسلاح النووي كضربة استباقية التنصُّل من أية اتهامات لها من الدولة المعتدية.
كما أنه على المستوى الفني العسكري؛ فإن هناك سلسلة من الإجراءات تضمن سلامة القرار المُتَّخذ في القيادة السياسية والعسكرية الإستراتيجية، وأنْ تضمن القوات النووية التي تم توجيه الأمر لها بالتحرُّك، أن الأمر أو التوجيه العسكري الذي وصلها، هو من الجهة المُخَوَّلة بذلك في هيئة الأركان، والتي هناك منظومة قرار لديها مجهزة لكل الاحتمالات، بما في ذلك اختفاء القيادة السياسية للدولة مع وجود تهديد نووي.