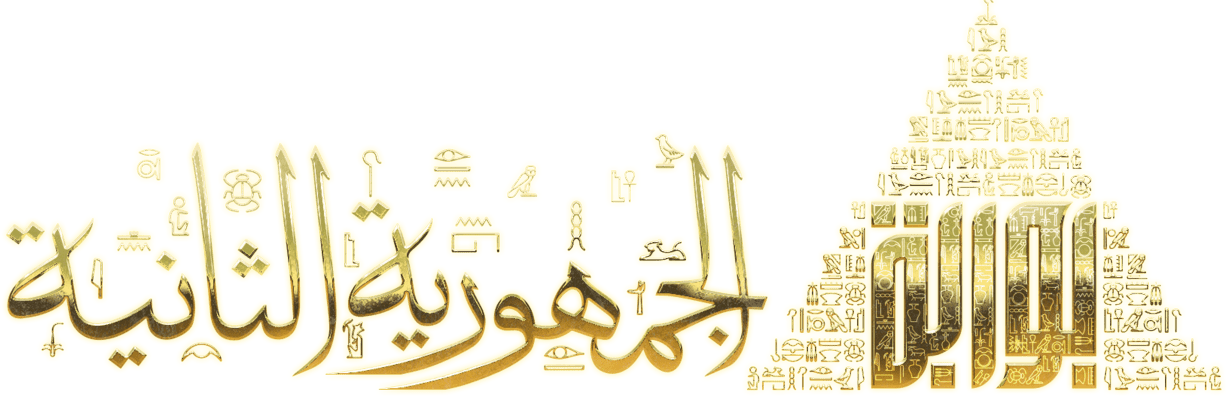إعداد: أحمد التلاوي
في قضايا الحياة والموت، والمواقف التي تتعلق بمصائر الأُمَم والشعوب؛ فإنه من أسوأ ما يمكن أنْ يقوم به العَوَام، تغليب العاطفة على اعتبارات الواقع الصلب، أما الأسوأ من ذلك، وضع العاطفة في قالب أخلاقي، مرتبط بالدين أو القيمة، أو وضع الأمر في إطار “حُسن النوايا” و”أخطاء الاجتهاد”.
فمن دروس التاريخ، وما صادَقَتْه كبار الحوادث التي صادفتها الإنسانية، فإن ضياع الحقوق، وتشويش الحقائق، يبدأ من هذه النقطة؛ حيث يتحول الموقف من مراجعات مطلوبة، وتقييم لازم، إلى بُكائيات، وإلى خطاب الحماسة الذي لا يحقق أي شيء في الواقع، بل على العكس.
هذا هو الموقف الحالي فيما يتعلق باغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، يحيى السنوار، وبالموقف الراهن في قطاع غزة والحرب هناك، والتي امتدَّ نطاقها إلى لبنان، ودول أخرى في المنطقة، إذا ما وضعنا في الحسبان اشتراك فصائل وميليشيات شيعية في العراق واليمن في الصراع الدائر، والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة في سوريا.
والحقيقة، أن مراجعة الأمور، ليست من نافل القول؛ حيث هي أحد أهم قوانين العمران، وأحد العلامات التي تهتدي بها الأُمَم الرامية إلى المُضِيِّ قُدُمًا على طريق التطور والتواصل الحضاري؛ حيث تضمن هذه المراجعات وما تتضمنه من إحداث تغيير ضروري في نهاية العملية، معرفة عناصر الضعف، والسعي إلى التغلب عليها، ومعرفة عناصر القوة وتعظيمها.
وبإسقاط ذلك على الحالة التي بين أيدينا؛ سوف نقف أمام الكثير من الأمور التي تجعل مما يمكن أنْ نطلق عليه وصف “إرث السنوار” وإخوانه، أحد أسوأ الأمور التي طرأت على الصراع العربي الإسرائيلي منذ نشأته، أو على الأقل منذ حرب أكتوبر 1973م.
ولا يتعلق تقييم “إرث السنوار”، بالحديث التقليدي الذي يملأ وسائل الإعلام عن نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لجهة الخسائر البشرية، والدمار الهائل الذي لَحِقَ بقطاع غزة، وتشريد سكانه البالغين 2.3 مليون نسمة، فهناك مَن يضع الأرقام الفادحة للحرب في خانة “تضحيات” الفلسطينيين الواجبة لأجل القضية الفلسطينية بالإضافة إلى أنها تملأ الآن وسائل الإعلام المختلفة في الذكرى الأولى للعملية المعروفة بـ”طوفان الأقصى”.
فمحور الإرث، هو أساس القضية، “وجود إسرائيل غير الشرعي في المنطقة”. فهذه العبارة السابقة، هي التي تختزل صلب وموضوع القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي بالكامل.
فالقضية الفلسطينية نتجت عن وجود أو حلول شعب محل شعب آخر على أرضه، اغتصابًا بالقوة، وبوسائل الإرهاب المختلفة، والصراع العربي الإسرائيلي، نتج عن وجود مشروع معادٍ للقيم والهوية الدينية والروحية لمحيطه العربي، ويهدد الأمن القومي لدول المنطقة، كما أثبت السلوك الإسرائيلي العدواني في العقود الماضية لأكثر من سبب، أهما مما يرتبط بموضوع هذا الحديث، التوسع الإقليمي.
فما هو تأثير عملية “طوفان الأقصى” بحسب أدبيات حركة “حماس”، في إطار كوننا في دائرة الذكرى الأولى لها، وفي إطار حدث اغتيال السنوار، المهندس الأساسي لها في هذا السياق السياسي والأمني السابق؟!.
في التعريف بإسرائيل
مبدأيًّا، فإن أي طَرَف يسعى إلى دخول معركة أو صراع ناجح مع طَرَف آخر، فإنه لابد أنْ يعرفه، وهناك مقولة أمريكية شهيرة تقول: “إذا أردت أنْ تقتل شخصًا، فعليك أن تعرفه إلى درجة الغرام”، أي أنْ تكون وثيق المعرفة به، كما لو كنت شديد التعلُّق به، والحب له.
وكانت هذه بالفعل أول خطوة خطتها القيادة السياسية والعسكرية والأمنية في مصر بعد هزيمة يونيو 1967م؛ حيث كان التوجيه الأساسي – وبالتحديد لجهاز المخابرات العامة المصرية – هو معرفة إسرائيل.
ولذلك، تم تأسيس مركز الدراسات الإسرائيلية في مؤسسة “الأهرام”، بمعرفة المخابرات العامة، في العام 1968م، وكذلك توجيه أنشطة الهيئة العامة للاستعلامات، من أجل هدف واحد؛ تحقيق المعرفة الحقيقية والكاملة عن إسرائيل.
ويمكن القول بكل ثقة، إن هذا كان أساس نجاح حرب أكتوبر؛ أنْ نعرف أي عَدُوٍّ نواجه؛ حيث ذلك الذي على أساسه تم وضع خطط الخداع الإستراتيجي والعمليات العسكرية، وتدريب القوات، وكل هذه الأمور.
وبتطبيق هذه القاعدة التأسيسية أو الأصولية في عالم السياسة والإستراتيجية، على الحالة التي نحن بصددها، فإن أول وأهم معرفة تتعلق بإسرائيل، ينبغي على أي ذوي شأن إدراكها، هي أنها كيان توسُّعِيٍّ غير شرعي، نشأ على الإرهاب، بالمعنى القانوني والسياسي للإرهاب، وبالتالي؛ يرتِّب ذلك نتيجة مفادها، أن إسرائيل كيان لا يمكنه أنْ يعيش ويستمر من دون حرب.
لماذا إسرائيل عدوة للسلام؟!
يترتَّب على ذلك، أن أكبر عَدُو للكيان الصهيوني، هو حالة سلام طويلة الأمد.
فحالة السلام طويلة المدى هذه، هي التي تحقق عاملَيْن؛ الأول، تحويل إسرائيل من مشروع إقليمي، وظيفي، له داعمون دوليون أسسوه في منطقتنا لأهداف بعينها، مشروع لا حدود واضحة أو معالم محددة له، إلى دولة ذات حدود ومعالم واضحة، تعيش مشكلاتها.
وبالتالي، تحصل فيها نتيجة تراجُع فكرة التهديد الوجودي – مما يفقِد المجتمع حاجته إلى التلاحم الكامل، وطابعه التضامني، في ظل فكرة وحدة المصير – شروخ مجتمعية وسياسية كبيرة، قد لا تكون في الغالب مرئية أو واضحة هناك.
أيضًا يساهم ذلك إلى ربط إسرائيل/ الدولة، لا إسرائيل/ المشروع بمصالح أمنية واقتصادية مهمة لها في الإقليم، وليس العكس؛ أنْ يكون امن الإقليم ومصالحه مرتبط بها.
أدرك الرئيس المصري أنور السادات ذلك، وربما بدت رؤيته هذه غير مقبولة وقت أنْ طرح مبادرته الشهيرة للسلام مع إسرائيل في العام 1977م، والتي نتج عنها اتفاقيات كامب ديفيد، 1978م، والسلام المصرية الإسرائيلية، 1979م، إلا أنه – مع تحفُّظ الكثيرين على الطريقة التي نفَّذ بها السادات هذه الرؤية – أثبتت صحتها، إذا ما رأينا حجم المشكلات والشروخ التي كشفت عنها عملية “طوفان الأقصى” في البنية الاجتماعية والسياسية، وكذلك الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
وبما أن عقلية القائمين على الدولة العبرية مختلفة عن عقلية القائمين على الفصائل الفلسطينية والتنظيمات الدينية، والأنظمة بشكل عام في المنطقة العربية والشرق الأوسط؛ فإنهم بكل تأكيد في إسرائيل – التي تأسست كدولة على النظم الغربية – لن تترك ما جرى من دون دراسته وفحصه بمنتهى الدقة، والعمل على تفاديه، في عملية تقييم ومراجعة شاملة بدأت بالفعل.
وكانت من النتائج الأولية لعملية التقييم والمراجعة هذه، تخريب جهد عقود طويلة من العمل الإستراتيجي داخل الكيان الصهيوني من أجل رصده بدقة، وإضعافه إذا ما تطلب الموقف.
كما أن أسوأ النتائج المتحققة، هي أنها استعادت في الداخل الإسرائيلي نغمة الوحدة والمصير الواحد، بعد أن قاد “إرث السنوار” إلى استعادة روح التهديد الوجودي بين الإسرائيليين.
ففي الأشهر السابقة على التصعيد مع “حزب الله” اللبناني، وإيران بدرجة أقل، ظهرت لنا أزمة حقيقية عميقة بين المكوِّن السياسي والحزبي في إسرائيل، بدا في مساعٍ حقيقية للمعارضة اليسارية والعلمانية لإسقاط حكومة اليمين المتطرف التي يقودها بنيامين نتنياهو وحزب “الليكود”، برغم الأزمة الأمنية الكبرى التي كانت تواجهها دولتهم.
كما رأينا في مظاهرات ذوي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، أن جزء كبير من الجمهور الإسرائيلي، كان قد تحول من جمهور “صهيوني”، لديه حِسُّ التضحية لأجل “أرض الميعاد” و”الوطن الموعود”، إلى جمهور “إسرائيلي”، يضع مصالحه ومطالبه على حساب الدولة.
هذه المعالم، قضت عليها تمامًا عملية “طوفان الأقصى”، وما تشمله من عمليات قامت بها فصائل وميليشيات مسلحة أخرى في الإقليم، تحت بند أو مُسَمَّى “إسناد غزة”.. حتى مظاهرات مَن تبقى من الرهائن الإسرائيليين في غزة، تراجعت بشكل كبير عندما بدأت معركة الجبهة الشمالية.
إسرائيل والعودة إلى نغمة التوسُّع الإقليمي
في السياق التعريفي السابق بإسرائيل، كنا نقصد كل كلمة قيلت فيه، ومن بين المصطلحات التي استعملناها، مصطلح “كيان توسُّعي”. فكيف كان “إرث السنوار” في هذه النقطة؟
في الحقيقة من المهم التذكير هنا إلى أن التوسُّع الإسرائيلي في المنطقة بالقوة العسكرية، لا يعود فقط إلى خرافات المشروع الصهيوني المبنية على جذر ديني أو تاريخي، وإنما لاعتبارات أمن قومي بحتة؛ حيث يعاني شكل الدولة العبرية الجيوسياسي لتشوُّهات كبيرة بالمفهوم الطبوغرافي، تجعل من السهل إسقاطه عسكريًّا، مثل “نتوء سهل الحَوْلَة” و”أصبع الجليل” و”نتوء غزة” والانبعاج الأردني.
ولكن، ومنذ اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979م، ثم اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل، واتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في التسعينيات، عرفت إسرائيل لغة الانسحاب وليس التوسُّع، ووصل المشهد إلى أقصى مدى له بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000م، ثم من قطاع غزة في العام 2005م.
ثم جاء الاحتلال الإسرائيلي الحالي لقطاع غزة، والذي أعلنت الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي وواضح، أنه سوف يستمر، وخططها المعلنة لاحتلال منطقة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، لكي تعيد لإسرائيل روح المشروع الصهيوني التوسُّعي.
فللمرَّة الأولى منذ عشرين عامًا، تخرج إسرائيل لما وراء حدودها، ومن خلال السلوك الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، والذي يعتمد على أربع ركائز أساسية، وهي:
- السيطرة على كل حدود قطاع غزة، وسواحله، ويشمل ذلك عزله عن مصر؛ حيث الجانب الوحيد لغزة الذي ليس له حدود مع إسرائيل، وهو ما تضمنه احتلال محور “صلاح الدين” / فيلادلفيا، ومنطقة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بل وتدمير المعبر بالكامل هناك.
- إنشاء مناطق عازلة على كامل حدود القطاع مع إسرائيل، تشمل مسح كامل للمباني الموجودة في خط الحدود.
- تنفيذ ما بات يُعرَف إعلاميًّا بـ”خطة الجنرالات” في شمال قطاع غزة، والتي تمثِّل تطبيقًا خاصًّا للنقطة السابقة؛ حيث يتم بالفعل تهجير كل سكانه، وتسوية المنطقة بالكامل بالأرض.
- احتلال محور “نتساريم” الذي يقسم قطاع غزة إلى شطرين غير متواصلَيْن جغرافيًّا، أو بشريًّا، وتمت بالفعل تسوية المناطق الواقعة حوله بالأرض، وبالتبعية إخلاؤها من السكان.
اعتبارات أمن قومي مصرية
الأمر الذي يمس الأمن القومي لمصر بشكل مباشر في هذا الصدد، هو أن قطاع غزة خارج ترتيبات اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وبالتالي هو خارج ترتيبات الملحق العسكري لها.
وعلى ذلك، فإن إسرائيل تتواجد حاليًا بقوات عسكرية كبيرة، بما فيها نقاط عسكرية ودبابات ومدرعات، على الحدود مع مصر، بعيدًا عن التقنين الذي وضعته الاتفاقية لحجم القوات الإسرائيلية في المنطقة (د)، المتاخِمة للحدود المصرية الإسرائيلية.
وبالرغم من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل؛ إلا أن المخطِّط العسكري المصري لا علاقة له بذلك، فهو عندما يضع خطط التأمين الدفاعي للدولة، يعتمد في ذلك على حجم قوات الدولة المجاورة، وقدرتها على التعبئة والحشد والفتح الإستراتيجي على الجبهة، وبالتالي مستوى سرعة أي هجوم يحدث منها على الأراضي المصرية.
وبالتالي؛ فإن “إرث السنوار” في هذه النقطة، سوف يلقي بالتأكيد أعباء إضافية على القوات المسلحة المصرية، باعتبار أن إسرائيل يمكنها من غزة، مهاجمة الأراضي المصرية في حال اندلاع أية أزمة مفاجئة، بقوات كبيرة، موجودة مباشرة بجوار الحدود مع مصر.
أيضًا، ومن خلال ما يتعلمه الطلبة في الكليات العسكرية، وطلبة العلوم السياسية؛ فإن تقييم الأثر يكون أيضًا برصد ما تم منعه، وما لم يحدث بالفعل، ولكن كانت الظروف والبيئة مهيَّأةً لحدوثه.
وأهم ما يندرج تحت هذا الاتجاه من التقييم، هو تهجير فلسطينيي القطاع إلى شمال سيناء، وهو هدف إسرائيلي تم العثور على آثار له حتى من قبل خطة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الجنرال إيجال آلون في العام 1968م، وحتى من قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني في العام 1948م، ضمن خططهم من أجل تصفية صُلْب القضية الفلسطينية، وهو ملف اللاجئين، والذي حاولوا فيه بالتهجير القسري، والتعويض، وكل الأدوات.
فكما كانت عملية “طوفان الأقصى”، فرصة مثالية لإسرائيل لرتق شروخها الداخلية، والعودة إلى قطاع غزة – لم تكن خطة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون للخروج من غزة في 2005م محل قبول من المجموع السياسي والعسكري والأمني الإسرائيلي وقتها – والتوسُّع الإقليمي مرَّة؛ فإنها كانت فرصة مثالية أيضًا لإسرائيل لدفع الفلسطينيين للخروج من القطاع قَسْرًا، ودفعهم إلى الأراضي المصرية.
وهذا الموضوع كان محل أزمة أمنية وسياسية كبرى واجهتها الدولة المصرية بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية والدبلوماسية في السنوات الماضية، وكانت “حماس” نفسها جزءًا منها في سنة حكم الإخوان المسلمين في مصر، وفي محطات أخرى، مثل “خطة القرن” الأصلية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي رفضتها مصر، وكانت تتضمَّن تبادلاً للأرضي، تمنح مصر بموجبها جزءًا من شمال سيناء لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيه، مقابل حصولها على جزء من الأراضي الصحراوية الإسرائيلية، عند منطقة “الكونتلة”.
كان ما مضى، هو فقط بعض معالم “إرث السنوار”، ونتائج عملية “طوفان الأقصى” على المستوى الإستراتيجي؛ حيث الأحداث الكبرى بحاجة إلى وقت أطول لفهمها وتقييم أثرها.
والحقيقة أن النتائج وخيمة، ولا يمكن الركون مطلقًا إلى “تبريرات” و”تفسيرات” الأطراف المؤيدة لـ”حماس”، وبخاصة منصات ودوائر جماعة “الإخوان المسلمون”، والمنصات الداعمة لها في قطر وتركيا ولندن، أو التسليم بالرؤية “الدينية” التي يطرحونها.
فحتى هذه الرؤية الدينية، يمكن تفنيدها بسهولة من جانب أي طالب علم، ودارس للتاريخ الإسلامي في عصر النبوة، ولكن هذا موضع آخر للحديث.