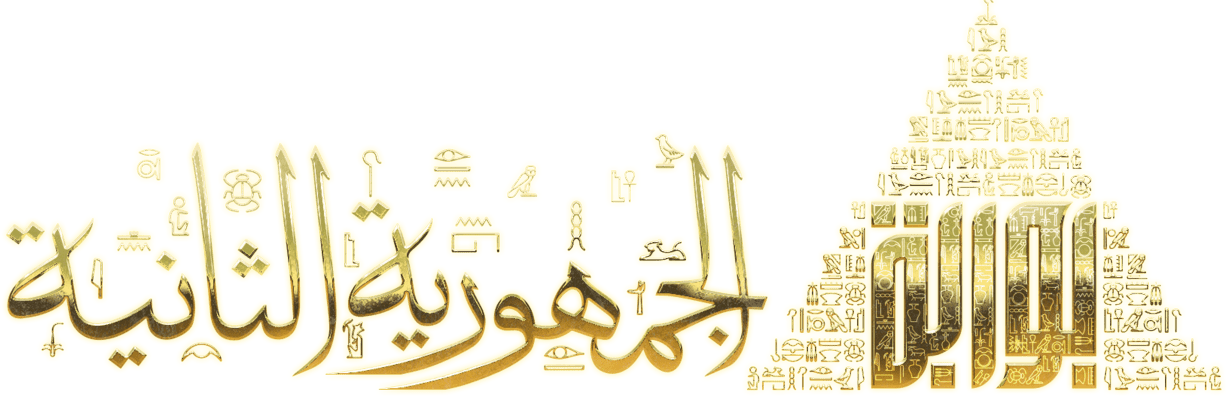أحمد التلاوي يكتب: لماذا ننتمي؟!.. ولماذا ينبغي لنا أنْ ننتمي؟!

من ضمن مظاهر أزمات المجتمعات وفق ما حددته قواعد علوم العمران والاجتماع، فقدان الهوية، وفقدان الانتماء لدى الكثير من المنتمين إلى مجتمع بعينه.
ويعود ذلك إلى طائفة واسعة من الأسباب، تظهرها لنا الدراسات التاريخية، من بينها الأزمات المعيشية، وعدم كفاءة برامج التعليم، وضعف أساليب التنشئة والتعبئة، سواء من خلال الإعلام، أو من خلال مؤسسة الأسرة، أو عندما تحدث تأثيرات خارجية ذات طابع هدَّام.
وبالتأكيد، وفق دقائق عملية توزيع الأدوار بين الحاكم والمحكومين، وهما الضلعان المتفاعلان في أي مجتمع أو أُمَّة، ويُشَكِّلان مع عنصر الأرض والحدود مفهوم الدولة الحديث؛ فإن المسؤولية بالأساس تقع على الحاكم / الدولة؛ حيث إن الدولة وفق منظور المدرسة الوظيفية، هي التي عليها تبني السياسات اللازمة من أجل ربط المواطنين بالبلد الذي يحملون جنسيته، وينتمون إليه.
وتلعب عملية صناعة السياسات العامة على أساس المصلحة العامة، دورًا مهمًّا في ذلك، من خلال تحقيق التماسك المجتمعي، وفق منظور وضعه أفلاطون قبل أربعة وعشرين قرنًا تقريبًا، للدور الوظيفي للدولة ولسياساتها في المجال العام.
ولكن هذا المنظور لمسألة الانتماء، ينطلق من النظرة الغربية للدولة، والتي على أساسها تشكَّلت الدولة القومية الحديثة “Nation State” بعد صلح ويستفاليا الذي أنهى الحروب الدينية والقومية في أوروبا، في العام 1648م.
فإنهاء الصراعات في أوروبا، قام على أساس المصلحة، أي تأسيس كيانات سياسية تضم مجموعات بشرية متناغمة، وتجد هذه المجموعات “مصالحها” في إقامة علاقات سلمية، تقوم على أساس تبادل المنفعة، سواء بين أفراد هذه المجموعات، أو الدول، أو بين هذه المجموعات وبين بعضها البعض.
وهو ما تأسست عليه نظرية “العقد الاجتماعي” التي وضعها جان جاك روسو، والتي تعني انهيار الدولة، أو تفكيك النظام السياسي الحاكم متى انهار العقد الاجتماعي بين المحكومين وبينه.
وهذه النظرة هي التي تم على أساسها تشكيل أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؛ عندما تم فرض منظومة تعاونية، نفعية، اقتصادية الطابع على الشعوب الأوروبية، من أجل منع اندلاع الصراعات فيما بينهم، باعتبار أن مصالحهم تكون في تعاونهم، فكانت المجموعة الأوروبية للفحم والصُّلب (1951م) التي كانت أساس الاتحاد الأوروبي الحالي.
ولكن هذه النظرة، تتجاوز الكثير من الأمور التي تخضع لمدرسة أخرى في التحليل، والتي تنظر إلى الأمور نظرة أكثر إنسانية، وترى في الانتماء فطرة إنسانية لا يمكن تجاوزها.
ففكرة الانتماء، التي تدخل فيها قضية الانتماء الوطني، وحب الأوطان، هي من الأمور المفطور عليها الإنسان، حتى لدى عبدة البقر والوثنيين والملحدين، وما عبادة الأجداد في بلدان مثل اليابان، إلا دليل على أن هذه الأمور فطرة فرضت نفسها حتى على أهم أمور الإنسان، وهي العقيدة؛ التي تنظِّم علاقة الإنسان بخالقه، وبنفسه، وبالآخرين.
في دراسات الحضارة والعمران، كانت أول خطوة على طريق المدنية، هي الحَضَر، والحَضَر يعني استقرار الجماعة البشرية في مكان ما، يستوي في ذلك الحَضَر الريفي والحَضَر المديني.
ووفق التاريخ المُدَوَّن، فإن الحَضَر الريفي، القائم على فكرة وجود مستوطنات أو مستعمرات بشرية مستقرَّة تمارس النشاط الزراعي، كان الشكل الأول للحضارة الإنسانية، والعمران الإنساني المُستَدَام والبنَّاء، وأسبق على الحَضَر المديني، والذي من كلاهما تطورت الدولة، التي تُعتَبر أعقد وأحدث صور انتظام الجماعات البشرية في إطار واحد.
والحَضَر، الذي يعني الاستقرار، هو ببساطة شديدة، معناه انتماء الإنسان لمكان ما، وارتباطه به، وبالمجموعة التي تعيش فيه معه؛ يجمعهم جميعًا هوية واحدة، ولسان واحد، ومصير مشترك.
ومصطلح “الوطن” أصلاً، لغويًّا، يعني “مكان الإقامة” أو “المكان الذي يسكنه الإنسان ويقيم فيه”، وهو منحوت من ذات الجذر اللغوي لكلمة “استيطان”، ومنها “مستوطنة”، أي سُكنَى أرض بعينها، ويكون لها معالم متمايزة، وهوية وكذا..
فنحن – إذًا – ننتمي لأننا جزء من المكان، وجزء من المجموعة البشرية التي تسكن هذا المكان، وننتمي إليها فعليًّا، وليس بالتعايُش، نحن منهم، وهم مِنَّا؛ لا أننا نعيش وسط جماعة بشرية ذات هوية أخرى، لتحقيق مصلحة ما، مثل العمل أو الزواج أو أي شيء من هذا القبيل من منظور نظرية المنفعة.
وحتى وفق هذا المنظور، منظور المنفعة، فإن الإنسان لابد من أنْ يكون له وطن ينتمي إليه، وشعب يكون منه، ويشعر أن له حقوق له فيه، وواجبات عليه، بحيث إذا ما كان لديه أية نواقص في حياته؛ أكملها له وطنه، أكملتها له المجموعة التي ينتمي إليها، سواء بمفهوم “الشعب” أو “الأُمَّة” بشكل عام التي ينتمي إليها، أو المجموعة المحلية التي يعيش فيها؛ الجيران، والزملاء، والأصدقاء.
فالوطن ليس فرصة عمل، أو مكان يستريح فيه الإنسان، أو حتى حيث يوجد الناس الذين يحبهم، وإلا حاججنا البعض بأنه يمكنه أنْ يجد ذلك في بلد آخر يبني فيه ذاته، ويجد فيه كل ذلك.
الوطن بالمعنى الموضوعي، هو حيث ينتمي الإنسان، وحيث جاء، وهي أمور لا يمكنه الفكاك منها، فالمصري، سوف يظل مصريًّا مهما حمل من جنسيات بلدان أخرى، لأنه جاء من قوم بعينهم، هم المصريون، وكذلك الفرنسيون؛ هم أبناء أُمَّة بعينها، ذات سمات متمايزة، وهوية واضحة مختلفة عن الأمم الأخرى، بتاريخ مشترك، ومصير مشترك، وأماني مشتركة.
فالانتماء للمكان، وللناس، أمر مفروض على الإنسان، فالإنسان لا يختار أبوَيْه، ولا المكان الذي ينتمون إليه، وبالتالي؛ جعله الله تعالى لنا فطرة، الانتماء إلى هذا كله، فطرة.
وهذا يمكن بسهولة التأكُّد منه، فهناك شعوب تعيش حول براكين، أو في صحاري، رملية أو جليدية، ويعانون أشدَّ المعاناة لإكمال حياتهم، وضمان بقاء ذريتهم وأُمَّتهم في هذا المكان، والحياة فيه، ولكنهم لا تجدهم يناقشون أبدًا فكرة المغادرة إلى مكان آخر أكثر أمنًا، أو تتوافر فيه سُبُل العَيْش.
ولولا ذلك؛ لكانت ألاسكا، أو صحراء منغوليا، أو مناطق حزام البراكين والزلازل في إندونيسيا واليابان، من دون سكان، ولكن – للغرابة – فإن شعوب هذه المناطق، الصعبة، التي تتعرض كل لحظة لخطر الفناء بواسطة كارثة طبيعية، هي الأكثر انتماءً لمناطقها.
على العكس؛ هم يجدون في الانتماء إلى هذا المكان، وإلى الشعب، إلى الوطن الذي يعيشون فيه، ونشأوا فيه كأُمَّة أو كقوم لهم هويتهم، منذ زمن بعيد، شكلاً من أشكال الكبرياء والكرامة.
والوطن – حتى بمفاهيم المنفعة مجددًا، ومنظور العلوم السياسية المجرَّدة – هو المكان الذي يضمن في الإنسان أنه بعد أنْ يُولَد وينشأ ويعيش وتحقق ذاته فيه؛ لن يأتي ترامب، أو حزب “البديل من أجل ألمانيا” لكي يطرده منه؛ لأنه ليس أمريكيًّا أو ألمانيًّا، أو عندما يحدث خلاف سياسي ما بين هذا البلد الذي يقطنه، وحتى وُلِدَ ونشأ فيه، مع بلده الأصلي؛ يتم طرده منه إلى لا مكان، فلا هو منتمٍ إلى وطن، ولا هو يستطيع أنْ يبقى هناك مكانه.
إذًا، فعلى غياب هذه الأمور، على بداهتها، وعلى مركزيتها وتأصُّلها في النفوس الصحيحة، السَّوِيَّة، فإن ذلك يعني أننا نواجه في مجتمعنا المصري، خللاً كبيرًا لدى شريحة من المصريين تأثَّرت بعوامل كثيرة، يعود بعضها إلى الأنظمة والحكومات المتعاقبة السابقة التي لم تهتم بهذه القضية، في نفوس الناس، وتركتهم نهبةً للتجهيل والإفقار، بحيث فقدوا الإحساس بهويتهم، وبانتمائهم.
وهو أمر لا يمكن توجيه الَّلوم فقط فيه لهؤلاء، فإحساس الإنسان بذاته، وتحقيقه لها، هو جزء من كرامته، والكرامة الإنسانية بمفهومها الواسع، أحد أهم مُحرِّكات الإنسان في حياته، فالجوع والتعرِّي وفقدان الأمان، من الأمور التي إذا ما افتقدها الإنسان، فإنه يفقد فيها كرامته.
أيضًا من الأسباب، كجزء من الفوضى الفكرية والاجتماعية والثقافية التي عايشناها منذ خمسة عقود، جاءت الجماعات الدينية المنحرفة، بفكرة مشوَّهة تمامًا لفكرة الانتماء الأممي الديني الذي يعلو على الانتماء الوطني أو القومي، وسفَّهت في هذا الأخير، من دون مبرر، إلا لتحقيق مصالح أطراف أخرى كانت هي التي توجهها، وزرعتها بين ظهرانينا لإضعافنا.
فكان للحفاظ على ولاء الشخص لتنظيم بعينه، هو نقض انتمائه إلى أي شيء آخر، حتى لوطنه، وللشعب الذي ينتمي له، حتى إن هذه الجماعات والتنظيمات أعلوا الانتماء للتنظيم على الانتماء الديني نفسه، فجعلوا الانتماء لتنظيم أو لجماعة بعينها، هو صنو الانتماء للدين، وأن المغادر للتنظيم، بمثابة مرتدٍّ عن الإسلام، وهناك نماذج كثيرة للغاية، تعرض فيها بعض الذين تنبَّهوا إلى طريق الضلال الذي يسيرون فيه، وحاولوا إصلاح مسارهم، أو انتقلوا إلى تنظيم آخر، بأفكار وفقه مختلفَيْن، فكان قتله كمرتدٍّ!
على ارتباط ما سبق في الفقرة الفائتة، بالعقيدة، فإن ذلك أنشأ خوفًا كبيرًا لدى العوام، وما يمكن أنْ نطلق عليهم أنصاف وجَهَلَة المتعلِّمين، من فكرة الإعلاء من شأن الانتماء الوطني، باعتباره “هرطقة” و”كفر” كما أوهمتهم عمائم الضلال.
ويعود هذا بنا إلى نقطة مركزية، وهي مسؤولية الدولة؛ التي أهملت التعليم والإعلام، مما أوجَد بيئة خصبة لانتشار هذه الأفكار، ومساحةً كبيرةً لهذه التنظيمات وأبواقها الإعلامية للتحرُّك بين ظهرانينا.
وللأسف، فإن هذه الظاهرة، ككل الظواهر المرتبطة بالإنسان والمجتمعات، تكون بحاجة إلى زمن طويل، وجهد كبير ومتواصل يُراكِم الأثر المطلوب لمعالجة مثل هذه الأمراض التي تحولت إلى ظواهر مزمنة، متجذِّرة.
إلا أنه يمكننا البدء بفكرة أن الانتماء فطرة، وضرورة مصلحية للإنسان، وطرح النماذج المفيدة كما رأينا؛ حيث يتمسك مئات الملايين من البشر بأوطانهم، ويفضلون الانتماء إليها، حتى ولو كانت صحراء قاحلة، أو قطعة أرض بجوار بركان.