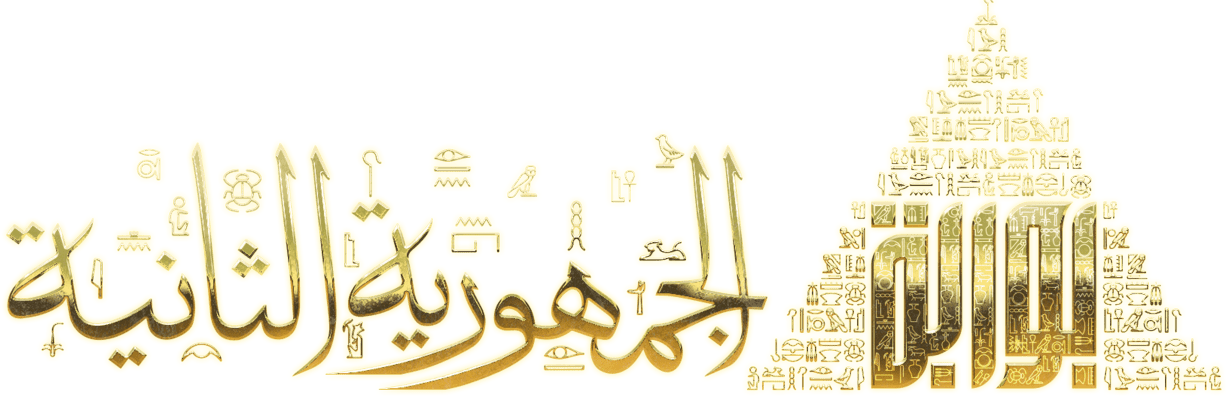إعداد: أحمد التلاوي
يفتح سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسقوط حكم حزب “البعث” في سوريا، والممتد على مدار ما يزيد على ستة عقود، المجال واسعًا للحديث عن مخاطر التدخلات الخارجية على الأمن القومي للدول، وبالتحديد مخاطر الاستجابة للعوامل التي تقود إلى التدخلات الخارجية في الدول المختلفة.
ونعني بذلك أن تكون حكومة الدولة المعنية طرفًا في هذه التدخلات، فالاعتداءات العسكرية والاحتلال تدخُّل كلها في نطاق التدخلات الخارجية، ولكن ما يعنينا في هذا التقرير، أمر آخر، وهو تلك التدخلات التي تكون الدولة نفسها طرفًا فيها، إمَّا باستدعاء الأجنبي للحضور لأي سبب من الأسباب، ومنها حماية النظام الحاكم نفسه، أو الانجرار وراء استدراجات خصومه، بما يجعله عُرضةً للمزيد من التدخلات الخارجية، ولاسيما إنْ أخطأ الحسابات.
تعرضت سوريا بسبب سياسات بشار الأسد بالتحديد، وليس على عموم سياسات حزب “البعث” طوال العقود التي حكم فيها البلاد، إلى الكثير من الأزمات، التي انتهت بتفكيكها فعليًّا، وتدمير مقدراتها، وبخاصة القوات المسلحة الوطنية بمعنى “National” وليس “Patriot”، بسبب مسألة التدخلات الخارجية وفق هذا المفهوم.
وقبل الاستطراد في رسم معالم الصورة المعقدة متعددة الأبعاد، من المهم الإشارة هنا إلى نموذج مُخالِف تمامًا، وكيف أن العمل وفق هذه النموذج المخالِف، قد صان الأمن القومي للدولة برغم كل ما تعرضت له من أعاصير في العقود الماضية، ونقصد الحالة المصرية.
فمن بين ما تُصِرُّ عليه القيادات السياسية والعسكرية المصرية المتعاقبة، أيًّا كانت خلفياتها وهويتها، من اعتبارات مصالح الأمن القومي، عدم وجود قواعد عسكرية أجنبية في مصر، أو في الدول المجاورة، أو ما يُعرَف بدول الجوار الحيوي الجيوسياسي.
ولا تقف مصر في هذا الإطار تتأمل كثيرًا أمام أية اعتبارات في هذا الصدد، حتى لو جاءت ضغوط من دول عظمى، مثلما فعل الرئيس الراحل حسني مبارك في الطلبات الأمريكية بشأن قاعدة في “رأس بناس”، ومثلما كان موقف الجمهورية الثانية من مسألة إقامة قواعد عسكرية روسية وتركية في السودان، في بورسودان وسواكن على الترتيب، والوجود العسكري التركي في ليبيا، وفي كل هذه الأحوال، كان الموقف المصري حاسمًا، ومؤثِّرًا.
وبالعودة إلى السياق الرئيسي للحديث؛ فإنه من المهم التأكيد على مركزية التدخلات الأجنبية في مسألة تفكيك سوريا التي تمضي على قَدَمٍ وساقٍ الآن؛ حيث الأكراد بحماية أمريكية يسيطرون على ما يزيد قليلاً على ربع مساحة سوريا، بينما تسيطر إسرائيل على هضبة الجولان وجبل الشيخ وما حولهما، بينما لا تزال روسيا متواجدة في مناطق الساحل السوري، فيما الولايات المتحدة تسيطر على مناطق واسعة من شمال وشمال شرق سوريا بقواعد ونقاط عسكرية أكدت الولايات المتحدة أنها لن تغادرها.
فكيف قادت سياسات بشار الأسد سوريا إلى هذا المصير؟!.. الإجابة نقف عليها في الإطار التالي.
حماية النظام مُقَدَّمة على حماية الدولة
كانت البداية عندما استحضر بشار الأسد “حزب الله” اللبناني و”الحرس الثوري” الإيراني، وفصائل شيعية أخرى من العراق ودول آسيا الوسطى، منها “الحشد الشعبي” الذي صار بعد ذلك جزءًا من القوات المسلحة النظامية العراقية، لحماية نظامه بعد بدء دول في المنطقة، وعبر الأطلنطي في تسليح الثورة السورية وتجنيد مجموعات إرهابية مسلحة لمهاجمة الأهداف العسكرية والمدنية التابعة للدولة السورية.
وفي الأصل، كانت الاستجابة شديدة العنف من جانب بشار وأجهزة نظامه في قمع الاحتجاجات التي انطلقت أولاً من درعا، ثم امتدت إلى سائر أنحاء سوريا، وكانت من العنف بحيث اعطت لجماعات مثل جماعة أبو مصعب الزرقاوي وتنظيم “القاعدة”، والذي جاءت منه “النصرة” ثم “هيئة تحرير الشام” التي يقودها رجل المرحلة الحالية، أبو محمد الجولاني الذي صار أحمد الشرع؛ نقول أعطت ردة فعل الدولة السورية في الأصل المبرر لهذه الجماعات بدخول سوريا بحجج تحمل طابعًا طائفيًّا أخذ حيزه على الأرض.
فكان انزلاق بشار إلى منزلق لم ينجرُّ إليه والده، الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وهو المنزلق الطائفي، فقابل هجمات الجماعات “السُّنِّيَّة” على القصير ومناطق الكثافات الشيعية والعلوية في سوريا باستدعاء الجماعات الشيعية المسلحة التي تتبع إيران أو هي في الأساس جزء من مؤسسات دولة ولاية الفقيه الإيرانية، فكانت مجازر مضايا والزبداني وغيرها من مناطق تمركزات السوريين السُّنَّة في المقابل.
ثم تطور ذلك إلى نوع جديد من التطهير على أساس سياسي؛ حيث إن المألوف عن جرائم التطهير – أي استبعاد مجموعة بشرية بعينها من مكان ما باستخدام الإرهاب والعنف المفرط بالقوة المسلحة – تتم إما على أساس ديني أو عرقي أو ما شابه من تصنيفات، لكن التطهير تم في سوريا على أساس سياسي؛ إما مؤيد للنظام؛ فيبقى، وإما معارض له، فيتم طرده من مناطقه.
فكانت النتيجة تهجير ونزوح أكثر من نصف الشعب السوري تقريبًا، ومع عدم تطابق هذا التصنيف مع التصنيف الطائفي؛ فإنه عندما ضعُفت شوكة النظام السوري وتخلَّى عنه حلفاؤه، ظهرت المواقف الحقيقية للقوى المحلية التي فضَّلت البقاء تحت حكم النظام عن النزوح بينما هي معارِضة تمامًا له، واستجابت لما بدأ يجري في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، عندما بدأت الفصائل المسلحة متعددة الجنسيات التي ترعاها تركيا في التحرُّك.
فكانت سياسة حماية النظام ودولة “البعث” مُقَدَّمة على حماية الدولة الوطنية، وهذه هي قاعدة الأساس لتدمير سوريا، بالإضافة إلى أثر عوامل أخرى.
الأهداف التركية والإسرائيلية في سوريا
من بين أهم الأطراف التي تدخَّلت في الأزمة السورية في الانفجار الأخير، تركيا وإسرائيل، ومن خلال التطورات على الأرض، وتصريحات المسؤولين في كلا البلدَيْن، وصولاً إلى مستوى رأس السلطة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ نقف عند تطابق كبير في المواقف.
تركيا التي كانت لها طموحات إقليمية في حلب السورية والموصل العراقية، مثل ليبيا وسواكن السودانية، انطلاقًا من وساوس العثمانيين الجدد، باستعادة مناطق نفوذهم، لم تستهدف كما قال الرئيس التركي في أكثر من مرَّة مصلحة سوريا والثورة السورية، وسوف نفهم ذلك حقيقةً فيما بعد.
أهداف تركيا محصورة الآن بين إعادة ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري في تركيا، قاد طول فترة بقائهم مع جنسيات أخرى احتضنها النظام التركي لاعتبارات سياسية متعلقة بدوره الوظيفي في المنطقة لصالح الغرب وحلف “الناتو”، أو انتمائه لتنظيم الإخوان الدولي، مثلما في حالة الإخوان المصريين أو حركة “حماس”، إلى ارتفاع مستوى الجرائم ذات الطابع العنصري ضد العرب بشكل عام والسوريين بشكل خاص، في تركيا.
أثَّرت هذه الأوضاع الأمنية على تركيز الدولة التركية على ملف الأمن الداخلي وكذلك على الاقتصاد، مما سمح للأكراد بتنفيذ عمليات مسلحة داخل الأراضي التركية، وكان آخرها العملية التي استهدفت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش” في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي.
فكان من المحتَّم على الأتراك البحث عن حلٍّ دائم لهذه الأزمة، فكانت المحاولات المستميتة لأردوغان لإقامة مصالحة مع النظام السوري المخلوع، ورفضها بشار الأسد، ولذلك كان البديل التحرك العسكري الأخير.
الهدف الثاني لأردوغان ونظامه، هو الأكراد، وبالذات تواجدهم في غرب الفرات، في منبج وتل رفعت، وهذا استطاع تحقيقه بمعاونة مرتزقة المجموعات التركمانية والأفغان والأوزبك وغيرها من الجنسيات التي تمركزت في شمال غرب سوريا، في السنوات الماضية، في التحرك العسكري الذي أطاح بالأسد.
إلا أنه – وهي نقطة شديدة الأهمية في تفاصيلها لأنها تكشف بعض كواليس ما جرى في سوريا وترتيباته – لم يمكنه العمل على ملف الأكراد في شرق الفرات، وذلك لأن الأمريكيين منعوه. فقط كل ما تم، هو التعامل مع الأكراد في مدينة دير الزور والبوكمال وريفها، وهي مناطق استولت عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” استغلالاً للاضطرابات التي أحدثها اجتياح حلب في بداية العملية العسكرية لـ”هيئة تحرير الشام” والفصائل الأخرى.
هنا تظهر تصريحات الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن المتكررة، ومسؤولي إدارته، وأهمهم وزير خارجيته أنتوني بلينكن وجون كيربي منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، حول الوضع في سوريا وما آل إليه.
فكان التأكيد أولاً على مسألة بقاء القوات الأمريكية في مناطق تنظيم الدولة “داعش” سابقًا والتشديد على أن العمل على منع عودة “داعش” مجددًا استغلالاً للفراغ الأمني والسياسي في سوريا، يتم بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية”، بما يعني وضع خطوط حمراء لأي تحرك لأردوغان ضد الأكراد، بحيث يظل المشروع الكردي التقسيمي في سوريا، وكذلك في تركيا والعراق وإيران، حيًّا.
الاستجابة التركية للخطوط الحمراء الأمريكية في صدد الأتراك، بالتوازي مع الترحيب “المريب” و”المُبَالغ فيه” من جانب الإدارة الأمريكية ليس بما جرى في سوريا بالتحديد، وإنما بالترتيب الذي جرت به الأمور، وأطرافه، وعلى رأسهم “هيئة تحرير الشام”، ثم خروج تصريحات لـ”مسؤولين أمريكيين” نشرتها الصحف الأمريكية بشأن رفع الهيئة من قائمة الإرهاب الأمريكية، يشير إلى تنسيق أمريكي تركي كامل فيما جرى ويجري في سوريا.
ولكن الأتراك لا يمكنهم أنْ يُغفِلوا حقيقة أن مناطق الحكم الذاتي الكردية في شمال وشمال شرق سوريا هي أكبر مهددات أمنهم القومي، لذلك يوعزون إلى حلفائهم السياسيين والجهاديين في سوريا إلى التأكيد على هدف مهم بالنسبة للأتراك، وهو عدم القبول بتقسيم سوريا، وأنْ سوريا يجب أنْ تبقى موحَّدة.
نعود هنا إلى دور النظام السوري الراحل في ذلك، في إطار مسألة استحضار التدخل الأجنبي المُدَمِّر إلى بلاده من خلال سياساته هو نفسه. فهو في إطار ألاعيبه السياسية، وردًّا على الدعم التركي السياسي والعسكري والاستخباري للمعارضة السورية في سنوات الحرب، لَعِبَ بورقة الأكراد، وكان ظنه أنْ يتوقف الأتراك عن سياساتهم في إضعاف النظام السوري، باعتبار أن ذلك يخلق البيئة المناسبة لتمدد المشروع الكردي، وامتداداته داخل تركيا ممثلة في “حزب العمال الكردستاني”.
ولكن – بموضوعية كاملة هنا – لا يمكن لأية دولة ذات مؤسسات قوية وراسخة مثل تركيا، أنْ تسمح لهكذا تهديد يمس وحدة ترابها الوطني، وكان لابد لها من التحرك، وإلا ظهرت بمظهر المفرِّط أمام شعبها، وتحمَّلت مسؤولية ذلك أمام التاريخ هناك.
ولذلك نفهم على سبيل المثال، عملية التفجير التي نفذتها الاستخبارات التركية في القامشلي في العاشر من ديسمبر الجاري، لتدمير أسلحة ثقيلة استولت عليها “قوات سوريا الديمقراطية” من ترسانة جيش الأسد.
نُدخِل هنا تصريحات مهمة للجولاني – الذي صار فجأة الشرع، ضمن عملية إضفاء الهوية السورية الوطنية “Nation” عليه، وعلى تنظيمه من جانب تركيا وإعلام التنظيم الدولي للإخوان – كررها في أكثر من موقف، وهي أن من أهم أهداف السلطة الجديدة في سوريا، وعمودها الفقري ميليشياته، منع إيران وحلفائها من العودة إلى سوريا، بينما لم يأتِ بحال على ذكر الاحتلال الإسرائيلي للجولان، والتوسع الجديد له، ولا الوجود العسكري الروسي في الساحل السوري.
القوات التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” والميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا، تحركت بوضوح لتحقيق هذا الهدف؛ حيث أغلقت معبر “البوكمال” الحدودي، وقامت بتأمين المناطق الحدودية مع العراق التي كانت تمثل معبرًا للميليشيات الإيرانية أو من شيعة الهازارا الأفغانية أو الأوزبك وغيرها من الجنسيات من بلدان آسيا الوسطى، وشحنات الأسلحة و”مستشاري” “الحرس الثوري” إلى ومن ثَمَّ إلى “حزب الله” في لبنان.
إسرائيل أيضًا تتحرك بنفس المنطق، وبنفس الأهداف، وهو ما قاله نتنياهو صراحة؛ حيث قال إن الأهداف الأساسية لإسرائيل في سوريا في الوقت الحالي، بجانب منع وقوع ترسانة الأسلحة التقليدية وغير التقليدية لجيش النظام السوري في أيدي “الجهاديين” كما يصف الجولاني وإخوانه، هو منع عودة “حزب الله” والميليشيات الإيرانية و”مستشاري” “الحرس الثوري” الإيراني إلى هناك، وفرض منطقة أمنية منزوعة السلاح في جنوب سوريا.
نتنياهو في تصريحاته، وخصوصًا التي أطلقها في يوم محاكمته بتهمة الفساد، الثلاثاء العاشر من ديسمبر، أظهر أنه لا مشكلة خاصة لدى إسرائيل مع “الجهاديين” والقوى الجديدة في سوريا، وإنما سوف تظهر المشكلة حال وجود أي تحرك من جانبهم ضد إسرائيل، أو متى عادت إيران وميليشياتها وحلفاؤها سوريا.
روسيا وقواعدها
في الحقيقة أن أحد أسوأ ألوان السياسات التي استقدم بها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، هو الوجود الروسي، والذي جاء لأسباب لا تتعلق بتأمين النظام السوري ومواجهة محاولات نشر الفوضى في سوريا، منذ بدء التدخل العسكري الروسي هناك، في 2015م، وإنما يتعلق بمصالح روسية محضة بطبيعة الحال.
ولكن الروس يلغبون ببراجماتية عالية للغاية، ومصالحهم متى تعارضت مع مصالح الحلفاء؛ فإنهم لا يُفَكِّرون مرتَيْن، حتى ولو كان في ذلك دمار حلفائهم، وهو ما بدا في سوريا الآن فعلاً.
الأهداف الروسية من التواجد العسكري الدائم في سوريا، هي أهداف قديمة قِدَم الإمبراطورية الروسية القيصرية، ومنها تأمين الوجود الروسي في المياه الدافئة.
كما كان التحرك الروسي في سوريا محاولة لاستعادة نفوذهم في المنطقة، والذي فقدوه بطريقة غريبة للغاية في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير 2011م، عندما امتنعت روسيا عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم (1973) الصادر في السابع عشر من مارس 2011م، الذي أعطى لحلف “الناتو” شرعية التدخل العسكري ضد نظام العقيد الليبي مُعَمَّر القذافي.
ومع وضوح التدخلات الإقليمية والدولية في الحرب السورية، التي أُطلِقَ عليها “حرب العالم”، واتجاه الأمور لسقوط نظام بشار الأسد، لم ترغب روسيا في تكرار ما جرى في ليبيا، وتفقد آخر معاقلها في المياه الدافئة، فكان التدخل العسكري في سوريا.
لكن الروس المُنشغلين بمستنقع الحرب في أوكرانيا، والعناد الذي أبداه الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تجاه أية محاولات للحل، جعل الروس يضحون به وبحلفائه الإيرانيين هناك نظير ضمان مصالحهم الأصلية، وهو الوجود الدائم في ساحل سوريا.
فالهدف لم يكن دعم نظام بشار بذاته، وإنما كان الحفاظ على النفوذ الروسي الأخير الباقي في البحر المتوسط.
رافق ذلك تحركات روسية كثيرة في إطار الصراع مع النفوذ الغربي، الفرنسي، والأنجلو أمريكي في منطقة الشرق الأوسط الكبير، بما في ذلك الانقلابات التي تمت في عدد من دول الساحل والصحراء الإفريقية ضد أنظمة وحكومات مدعومة من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ولكن قد يكون لهذا موضع آخر للحديث.
سوريا.. أوضاع هَشَّة وأفق غامض
بكل تأكيد، ومهما كانت النوايا مخلصة كفرضية جَدَلِيَّة، عند القوى الجديدة الحاكمة في سوريا؛ فإن ما جرى لم يكن سهلاً، ولم يترك المجال لأية مصالحة؛ حيث طال التدمير النسيج المجتمعي السوري بالكامل، وصارت العشائرية، وليس الطائفية حتى، هي وحدة تكوينه، وليس المكون الرئيسي له.
لم يكن ذلك بسبب سياسات مناوئي بشار الأسد، في الخليج وتركيا وغيرها فحسب – كان تجنيد المرتزقة للقتال في الميليشيات التي تحارب النظام السوري، يتم بمعرفة التنظيم الدولي للإخوان، في بريطانيا، في أوساط المهاجرين واللاجئين المسلمين هناك – وإنما بسبب سياسات بشار الأسد نفسه.
فهو الذي تلاعب بهذه الورقة، ورقة إظهار التناقضات الداخلية، ظَنًّا منه أنها سياسة سوف تساعده في إحكام قبضته الداخلية من خلال إضعاف القوى الموجودة، ولم يكن يعرف أن فيها نهايته.
يُضاف إلى ذلك، أن النوايا ليست مخلصة بالفعل، وهو ما بدأ يأخذ مساراته علنيةً على شاشات الفضائيات؛ حيث بدأت قيادات وأعضاء في الائتلاف السوري المُعارِض، الجسم السياسي الرئيسي للمعارضة السورية، في الشكوى من انفراد الجولاني بالقرار، وفرضه الصبغة الإسلامية على الترتيبات التي بدأت للمرحلة الانتقالية، بما يتنافى مع الدعوات لدولة مدنية بمشاركة كل الأطياف في سوريا، وما تعهَّد به الجولاني نفسه في ذلك.
فبجانب رفع علم “هيئة تحرير الشام” بجانب العلم السوري الجديد، والمادة التي يبثُّها التليفزيون الرسمي السوري، بطابعها “الجهادي” لو صحَّ التعبير؛ فإن الدكتور محمد البشير، رئيس الوزراء السوري المؤقت الجديد، هو من قيادات تنظيم إخوان سوريا.
ولقد علَّق مراقبون في الولايات المتحدة على ذلك بنقطة مهمة، وهي أن هناك تنسيق رسمي أمريكي مسبق مع الإخوان المسلمين بالتحديد فيما جرى ولا يزال يجري في سوريا، وبالتبعية “الجهاديين” بحسب وصف نتنياهو لهم، وهو ما لا يمكن أنْ يتم من دون المرور على بريطانيا؛ حيث مقر التنظيم الدولي للإخوان، ومنبع الترتيب الأصلي لهذا كله.
ويميل هؤلاء المراقبون إلى ترجيح أنه قد تم أمريكيًّا اختيار النموذج الأفغاني لسوريا، بعدما أدت السياسات الأمريكية هناك إلى تمكين “طالبان” مجددًا بعد أكثر من عشرين عامًا من الإطاحة بها في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، في حرب أتت على المزيد من الأخضر واليابس في أفغانستان، وأدت لمزيد من التفكيك للمجتمع الأفغاني المُشَتَّت أصلاً، مما دفع الكثيرين للتساؤل عن سبب الإطاحة بها وقتها من الأساس!
السيناريو الثاني المطروح لسوريا، هو سيناريو الصومال، وليس “الَّلبْنَنَة”؛ حيث لبنان لا يزال في النهاية دولة واحدة بحكومة واحدة وبرلمان واجد وجيش واحد بقطع النظر عن الانقسامات السياسية والطائفية التي فيه، ولكن صومال ما بعد محمد سياد بِرِّي تبدو حالة مطابِقة أكثر لما هو الوضع عليه والمرجَّح استمراره في سوريا؛ حيث إنه بالرغم من أن الصومال لا يزال دولة واحدة صوريًّا أو اسميًّا، إلا أن هناك ثلاثة كيانات مستقلة عن بعضها البعض فيه، وهي “جمهورية صوماليلاند” أو “أرض الصومال” و”جمهورية بلاد بونت” أو “بونتلاند” بجانب الصومال الذي توجد فيه الحكومة المركزية والعاصمة مقديشو.
فبالمثل؛ هناك الآن في سوريا، مناطق السيطرة الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، ومناطق الساحل السوري؛ حيث تمركزات الشيعة العلويين الذين حكموا سوريا في العقود الطويلة الماضية، والتي لا تزل خارج سيطرة المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، التي تحظى بأكبر قدر من النفوذ الآن في سوريا في مقابل تراجع كبير لإيران بعض الضربات الإسرائيلية الأخيرة لها، في أكتوبر الماضي، ولـ”حزب الله” اللبناني، ولـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي في فلسطين”.
ثم هناك مناطق جنوبي سوريا بجانب الحدود مع الأردن؛ حيث العشائرية هناك هي المسيطرة برغم وجود فصائل تعلن ولاءها للجولاني، ثم الجولان وما حوله الذي تحتله إسرائيل ولا تزال تتوسَّع فيه.
وفي الأخير، فإن الصورة شديدة التعقيد مما لا يمكن الإلمام بها في حَيِّز واحد، بالإضافة إلى سوف يحمله المستقبل بالتأكيد من تطورات، من أهمها ما يرتبط بتولِّي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه، برؤاه وأجندته المختلفة تمامًا عن إدارة سلفه جوزيف بايدن.
ومنها أيضًا ما يرتبط بمدى قدرة حلفاء تركيا على بسط نفوذهم الجديد في سوريا، وما إذا كانت أصحاب النفوذ القدامى؛ “البعث” وإيران وحلفاؤها، سوف يسلِّمون بالأمر الواقع، ويرضخون، وبخاصة في ظل وضوح أجندة ترامب تجاه إيران، أم أن التراجع الحالي هو فقط لمجرد امتصاص الموقف، ثم بدء الارتداد بعد ذلك. هذا فقط ما سوف تكشف عنه الأيام والتطورات المقبلة.